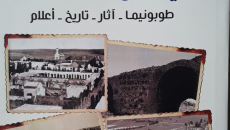شانغهاي جرح الصين الذي انْدَمَل:
لعب المخيال السينمائي الهُوليودي دورا في أَسْطرة “المدينة الساحرة”133شنغهاي، ووسمها بميسم الاحتيال والفقر والدعارة: “كانت في ذهني طوال الطريق مشاهد فيلم أمريكي تدور حوادثه في شنغهاي، وطبعا المحتالون واللصوص والشحاذون الغامضون هم شخوص الفيلم المثير، بالإضافة إلى النساء الخطِرات وعاهرات شانغهاي”134.
غير أن الحِسّ التاريخي سيوقظ في المؤلفة حِسّ عالمة الاقتصاد والاجتماع، فتضع الأصبع على منبع الجرح. أثناء حرب الأفيون تحولت شنغهاي إلى مستعمرة للفرنسيين والإنجليز والأمريكان واليابانيين، الذين عاثوا فيها فسادا: “المرأة في شانغهاي، كما هو الحال في هونغ كونغ من أكثر نساء الصين اكتواء بويلات ومصائب الاستعمار، فقد كانت تنفر من الظلم العام الواقع على الجميع، والظلم الخاص الواقع عليها كامرأة في مجتمع هو ميناء مفتوح، أدى إلى تأزم وضع المرأة بصورة درامية مع تردي أعداد كبيرة من النساء في هاوية الرذيلة…من جانب الجنود والمستعمر الداعر”135 ومصدر هذا الظلم الاستعماري الداعر الماحق لقيم المجتمع الصيني حسب المؤلفة هو الجهل والفقر: “هذا الفقر الماحق قد دفع الناس إلى بيع بناتهم الصبايا واللواتي حول الخامسة، للمواخير.
وقد اتشرت بفعل الحاجة تجارة الرقيق الأبيض…يقال إن الناس كانوا يتبادلون أبناءهم ليأكلوهم”136. غير أن غمامة هذه الصورة البشِعة، سرعان ما انقشعت بإكسير الاختيار السياسي الاشتراكي التحريري الذي “أتى بالحرية والكرامة”137، أمَا وقدْ “تم محو الأمية138 بين النساء مع نهاية 1957م”139. وخير معلِّم بالنسبة لماوْ تسي تونغ هو العمل ضامن الكرامة والوعي: “أرسلوهن للعمل وسيتعلمن بالممارسة”140 (ماو). وبذلك “استطاعت المرأة الصينية التغلب على جميع مشكلات عدم المساواة…[و] أصبحت المساواة أمرا يُكتسَبُ بالممارسة”141. وقد عمَّت هذه المساواة ـ في إطار العدالة الاجتماعية ـ “الأطفال غير الشرعيين [الذين] يتمتعون بنفس حقوق الأطفال الشرعيين”142 ونظرا لاهتمام خديجة صفوت الشديد بقضية المرأة، في كتاباتها الفكرية والأدبية معا، لم تخطئ عينها اللَّمَّاحة الدور الفعّال للمرأة الصينية في مجالات شتى، عَدَا المشاركة في الجيش الأحمر وحرب التحرير، منها:1ـ توثيق صِلاتها بالجيران وحفظ نفسها بمظهر لائق مُشرِّف ورعاية أبنائها على الوجه الصالح. وتنشئتهم على حب العمل والوعي الوطني الصحيح وتنمية مواهبهم العاطفية وقواهم الإنسانية الخلاّقة. 2ـ
اتخاذ دور فعال في النشاط الاجتماعي وتأهيل نفسها لعضوية مشرفة في المجتمع. 3ـ المساهمة في التوعية العامة بالاشتراك في حملات محو الأمية. 4ـ المساهمة في رفع الذوق العام بين النساء بتطوير الفنون المنزلية البسيطة لخلق أجواء حياتية سعيدة للجيل الناشئ. 5ـ تشجيع حركة التثقيف الواسعة143
كانتون الوجه الآخر لاسترقاق العقل:
الوجه الآخر للاسترقاق الجنسي هو استرقاق العقل واعتقاله بتخديره. ولذلك اعتبرت الكاتبة تجارة الجسد (الجنس) وتجارة العقل (الأفيون) وجهان لعملة واحدة يقصد
منها تصريف التخلف وتكريسه بطريقة تسلب الشعب جسده وعقله، وبالتالي تسلبه إرادته من أجل استعماره من قِبل طُغْمة من القراصنة والأفاقين والمقامرين: “كانت كانتون من أكثر مدن الصين تعرضا لهجمات القراصنة الأوروبيين والمقامرين والأفاقين. وعن طريق هؤلاء القراصنة تسربت آفة..تجارة الأفيون التي جرّت على الصين حربا ضروسا144كانت نتيجتها وقوع البلاد تحت سيطرة الاستعمار”145. وطبعا لتشريح هذه المعضلة، التي قلبت الميزان التجاري الذي كان لصالح الصين يوم كانت بريطانيا العظمى في حاجة ماسة إلى شاي الصين وسُكَّره، لجأت إلى تطعيم النص الرحلي بخطاب تاريخي يمكن في ضوئه فهم ماذا حصل؟ وما هي ملابسات إحكام الطوق على الصين؟ وكيف تم خروج الشعب الصيني من هذه الشرنقة؟
حرب الأفيون 1840 ـ 1842
في الصين، كانت التجارة الخارجية محصورة جدا وموقوفة على ثغر بّيكين منذ حكم المانشو في عهد أسرة تْشِنج في القرن الثامن عشر. وسرعان ما خرجت بريطانيا العظمى لفتح الصين عن طريق شركة الهند الشرقية، فغزت البضائع البريطانية أسواق الصين خاصة بالمنسوجات، مقابل ذلك كانت بريطانيا في حاجة إلى شاي الصين وسكّره. وكان الميزان التجاري لصالح الصين، وجاء الأفيون ليحول اتجاه الميزان146. فترتَّب عن ذلك تصدع الدخل القومي وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضخم رؤوس الأموال لدى تجار كانتون، مما دعا حكومة المانشو إلى تحريم تعاطي الأفيون ومنع تجارته147. فكان أن أعلنت بريطانيا الحرب، لتنهزم148 قوات كانتون بأسلحتها القديمة، ولحِق ضرر كبير باقتصاد الصين وصناعتها.
حرب الأفيون الثانية 1856 ـ 1860
لَئِن كانت حرب الأفيون الأولى قد انتهت بـ”تسليم هوج كونج”، فإن حرب الأفيون الثانية149دفعت الصين إلى تقديم تعويضات باهضة150، وتنازلات مجحفة، أفضت إلى استيطان بّيكين، وبالتالي استعمار الصين وتخريب معالمها الحضارية، رغم مماطلة حكومة مانشو في توقيع هذه المعاهدات، فكان أن اقتحمت القوات الفرنسية والبريطانية “قصر الصيف بعد أن نهبت كنوزه وسلبت نفائسه وأثرياته ثم أحرقت مبانيه. والذي يعرف مدى روعة الأبنية التي تتجلى فيها عبقرية وأصالة الفن والدقة الصينية، عدا الكنوز التي لا تقدر بما والتي كانت تنعكس حتى على زخارف وتصميم القصر، يعلم مدى وحشية ودناءة هؤلاء القوم الذين كان على الصين الاكتواء بهم قرنا طويلا”151
العمل، النظام، السلام:
ثالوث الصين المقدَّس:
لعل لغة الأرقام نابت كثيرا عن الإفاضة في وصف الصينيين، و”شهرة نظافة الشعب الصيني وترتيبه”152. فالأرقام تنبئ بتحولات أبهرت المؤلفة إلى حد أكسبها مناعةً من الدهشة والانبهار، لفرط ما تعوّدت على مظاهرهما في المجتمع الصيني. وكل ذلك نتاج العمل الدؤوب وضبط الوقت والنظام في كل شيء والتواضع الجم، وهو الشيء الوحيد الذي لم تجد مناعة تقيها الاندهاش منه والانبهار به، على حد قولها: “إلا أن الذي لم نملك ـ حتى النهاية ـ تَعَوُّدَه هو تواضع هؤلاء القوم الجَمّ”153 إن الصينيين “لا يعرفون القيلولة.. وهم في حركة دائمة إما في العمل وإما في النزهة”154. ومن شدة حبهم للنظام مشاركة الأهالي في حملة الصحة العامة وإبادة الذباب والحشرات والنظافة عام 1951م، ومشاركة أغلب السكان وجميع الطلبة في عملية رصف وتوسيع الشوارع وشق مجاري المياه155 هكذا أصبحت مدن الصين نظيفة، لكن “هانشو أنظف المدن التي رأينا على الإطلاق”156 ومن مظاهر النظام أن “شوارع بّكين التي تمرّ بوسط المدينة واسعة حتى لتكاد عشر سيارات تمر بها، وحركة المرور منظمة للغاية.. وقليلا ما تسمع صوت بوق.. وحوادث المرور نادرة، نظرا لسعة الشوارع وحب الصينيين للنظام”157.
ومن شدة الضبط لديهم أن القطارات “جميعها مؤقتة كالساعة”158. والخلاصة التي خرجت بها المؤلفة من تلك التوصيفات هي أن “الشعب الصيني أكثر شعوب الأرض تهذيبا وحبا للنظام ووعيا به وتواضعا أيضا”159 ولما كانت بصدد الحديث مع مِسْ نِي عن “مهارة الصينيين وإتقانهم”160، قالت لها: “الشعب الصيني شعب عظيم”؟ فأجابت مِسْنِي: “كل شعب عظيم”. إنها على حق: “كل الشعوب عظيمة”161. بهذا التبرير المنطقي خرجت إلى خلاصة الخلاصات في مشروعها الفكري الطاعن في الانحياز إلى الشعب. ولأن “الصيني مُهَذَّب”162، فهو “مسالم بطبعه، يتطلع إلى السلام كهدف جليل من الصيحة الأولى التي أطلقها صُنْيَاتْ صِنْ كالسِّحر في الشعب.. والفلكلور الصيني يُعنى بإبراز هذا الجانب في جميع أوجه الفنون القومية. ومن أشهر الأغنيات الشائعة في الصين أغنية مطلعها: (الأم وان تحب السلام)”163 وإذ أن “السلام شعار رسمي لجمهورية الصين الشعبية، [فإن الصين]حصن جبّار للسلم”164. ولذلك “يطلق اسم السلام على كثير من المؤسسات الكبرى كالمدارس ودور الحضانة والفنادق.. وكذلك الحمامة الرمزية تمثل شعارا تقليديا هي من أبرز وحدات الزخرفة المعمارية والفنية.
فالفنادق والمدارس والقاعات في الجامعات والمعاهد والمكتبات العامة جميعها مزدانة بالحمامة والغصن مطبوعة أو منحوتة وأيضا الأشغال اليدوية التي نزخرف بها ملابس الأطفال وأغطيتهم وأطراف المناديل…”165 ولم تخْفِ المؤلفة إعجابها الشديد بمختلف مظاهر تمجيد السلام، إضافة إلى تمجيد الأمومة والفلاحة، فعلى أرصفة المحطات “كل الصور تمجِّد الأمومة والطفولة والحصاد والسلام، فأي مجد، وأي روعة!”166. كما لم تُغفِل “دور الشعب الصيني إبان الاعتداء الثلاثي على مصر وتضامنه مع الشعوب العربية”167 وكما تحبّ أن تخرج دائما بالخلاصات العزيزة على قلبها ـ وهي في العمق تجسد أحلامها وآمالها واستيهاماتها التي ناضلت من أجلها طوال حياتها ـ انتهت إلى أن “الصين في ظل السلام الذي تنتهِجُهُ سياسةً لها تستطيع بمواردها ومقدراتها إحراز أروع النهايات”168، ما دام الشعب قد تخلَّص من عقدة النقص وغيرها من العادات القديمة التي تعوق تقدّم الشعوب: “ترى كثيرا من العادات القديمة قد زالت مثل الانفعالية والشعور بالنقص وعدم المساواة”169. ولربما هذا ما جعل من الإنسان الصيني إنسانا كونيا في نظر الرحالة.
كونية الإنسان الصيني:
إن حب الصيني للسلام، ودفاعه عن الآخر أنى كان من أجل السلام، دون أن ننسى “الكرم الصيني”170،ونبل المشاعر، والترحيب بالوافد، كلها قِيَم تزكي العمق الإنساني للشعب الصيني. لقد ولّد الاستقبال في بِّكين إحساسا لا قِب لها به ، وهي ترقُبُ “عشرات من المستقبلين، وعشرات من باقات الورود الأنيقة”171، تعبر عن “أنبل المشاعر.. في موجة من الانفعالات والفرح والرهبة..لا عهد لقلوبنا الإفريقية بمثلها”172الترحيب ثم الترحيب فالترحيب “والترحيب دائما ابتسام وورود لا حصر لأنواعها وألوانها الوادعة دائما انفعالات جياشة وأناشيد حماسية وأذرع تلوح حتى مدى البصر”173انفعالات تولِّد فيضا من المشاعر لا عهد للقلب الإفريقي بها، ولا طاقة للفكر على تحمُّل دفقاتها. فقد يتحدّر الدمع من شدة الفرح: “عشتُ ..لحظةً رهيبة بالنسبة لفكري الذي شلَّه الانفعال الدافق.. لم أحتمل كل هذا الفيض من المشاعر التي تبعث في النفس الحنين إلى البكاء”174 لقد عاشت المؤلفة تجربة العمق الإنساني للصينيين، حينما ألمَّت بها وعكة صحية بسيطة: “هؤلاء القوم يحسبون حساب أقل وعكة.. وقد استمتعنا بأكبر كمية من التدليل خلال تلك الأيام، فقد كانت تكفي أقل شكوى ولو حتى إرهاق لإسراع الطبيب. الأمر الذي لا يجده الإنسان حتى بين ذويه”175 وفي مثل هذه السياقات وغيرها، استشعرت المؤلفة صفاء العاطفة الصينية ونبلها، حتى إنها لترى أن إنسانيتهم لَتَقْصُر عنها أية إنسانية أخرى. وصيغ التفضيل الواردة في النص الموالي كفيلة بتبيان ذلك: “أجمل ذكرياتي على الإطلاق تلك الأيام المفعمة بأصفى العواطف وأنبلها بين قوم هم أكثر الناس إنسانية”176. ولعل كونية الصيني في عين المؤلفة لا تقف عند حبّ الآخرين له، بل أيضا وأساسا عند حبِّه للإنسانية قاطبة، لأنه إنسان اشتراكي كما توحي بذلك ليكسيمات: (زرع، عُمّال، حب الأرض، تقديس الأبطال أو الزعماء في العبارة الموالية: “الصيني يمجد الزرع والحمام والأطفال والصداقة ويُقدِّس أبطاله ويحترم التقاليد والعُمّال ويُحِب الأرض …يحب الإنسانية جمعاء”177 ودفقة الإنسانية هذه لمستها المؤلفة أيضا في تعامل الصينيين مع العجَزة، الذين أُعدَّت لهم “بيوت الكبار”.
وهنا تأتي المقارنة مرة أخرى كاستراتيجية خطابية لانتقاد الذات وتثمين قيم الآخر بتوصيف مرهف”: “نسميها عندنا بملاجئ العجزة، مع فارق كبير بين الاثنين. فبيت الكبار يقع على ربوة مرتفعة تشرف على واد غابي رائع المشهد الذي تطل عليه الفيلا خلاب للغاية وقد غرست حديقة كبيرة حول المكان تنتهي بدغل صغير تلتفه الأشجار المحيطة178”.
وفي دار الكبار ترى أيضا “المرأة جالسة بهدوء ترقب زميلا يرسم لوحة أو اثنين يتعاونان في زخرفة آنية”179. والكل ـ نساء ورجالا ـ يتمتّع بممارسة ما يهواه ويرغب فيه: “في هذه الغرفة يتمتع النزيل بممارسة جميع رغباته من هوايات جمع صور أو طوابع أو رسم أو نحت.. وأجمل ما يلفت النظر هو النظام الدقيق الذي يراعيه الجميع والهدوء الشامل الذي يضفي على المكان جوا مريحا ومحببا، فتجد الغرف منسقة على نحو مدهش وبهيج معا. فالزهور واللوحات والتهوية الصحيحة والإضاءة أبرز ما يميز المكان. ولدى هؤلاء الكبار وسائل أخرى للتسلية غير الرسم وزخرفة الخزف وغرس الزهور.
فبالدار قاعات للشطرنج والورق وأخرى للموسيقى وثالثة للقراءة ورابعة للبلياردو.. كما أن هناك قاعتين للاجتماع إلى جانب قاعات التدخين والطعام والاستقبال”180
شعرية الفضاء:
غمامة في خِفّة الجناحشدَّت روعة المناظر في الصين اهتمام الكاتبة، وخلقت لديها انتباهات أجّجت خيالها الملتهب بصور شعرية مغموسة في السِّرِّية والغموض حدَّ الأَسْطرة:”عبرنا شوارع بِّكين المغتسلة بالمطر الخفيف كأنه (دُشّ) ملطف عقب موعد هام. الصباح رمادي هادئ، وغمامات شفيفة تحوم حول بِّكين في خِفّة الجناح الرشيق وجلاله ـ وسحابات قريبة تغلف قمم المباني الشاهقة وتكاد تُخفي أَسِنّة الأبراج فتبللها مثل رسوم وصور في قصة خيالية أو خيال القصور في بركة صافية، وقطرات المطر تأبى إلا أن تتساقط على الطريق المصقول في رتابة وتلاحق، يحيل الإسفلت إلى صفحة لامعة تعكس كل ما يدور وكل ما هو قائم وكأنه نَبَت منها. وطبقات الضباب تتكاثف وتدثر بِّكين في غلالة رمادية مطرزة بماسات تبدو وكأنها نقاب العروس يوم زفافها وقد زاد من روعتها”181
ثلاثة أقمار وسط بحيرة:
لم تكن بِّكين وحدها مناط إعجاب غامض آسر لدى المؤلفة، فهذه مدينة هانشو بأقمارها الثلاثة أعجب العُجاب، وأشد سحرا من السحر، وأبعد غورا من الأسطورة، وأقوى من أن تتحمّله نفس بصيغة المفرد: “وفي هانشو أيضا رأينا أعجب المناظر: ذلك برج في وسط البحيرة يُرى منه القمر ثلاثة، وقد وُعِدنا برؤية هذا المشهد في ساعات معيَّنة. وجلستُ أفكِّر: هل أحتمل كل هذا الجمال وحدي وذكرت آخرين أحببت أن يشاركونيه، إنه أكثر مما أستطيع، قمر وأمواه وفنّ وأجواء”182
زنبقة غريبة:
هذا الحلم الذي عاشت فيه لقاءً فاتنا بين الأمواه والقمر لا يحصل إلا في ساعات معينة، شبيه بحلم آخر في ميقات معلوم، ميقات تفتُّح زنبقة غريبة مرة واحدة في السّنة، ولّد لديها إحساسا غامضا متضاربا بين السعادة والكآبة183، البِشْر والانقباض، اللهفة والأسى:”لقد تفتحت زنبقة لا أذكر اسمها لا تفعل ذلك إلا مرة كل عام. وكانت لحظة نادرة. وحول وعاء النبتة الخزفي الرائع أيضا رأيناها تتفتح ببطء وهدوء مواظبين كرئتين أخلي سبيلهما لتمتلئا بالهواء والحياة. زنبقة شمعية البياض هائلة الحجم تتفتح مرة كل عام وتظل كذلك لأسابيع ثم تعود إلى الانطواء ضامة كأسها العجيب الخضرة المؤلفة تباينا عبقريا مع بياض الأوراق لتتفتح بعد عام. حين يتحول الكأس الأخضر إلى برعم جديد ثم زنبقة وتتحول الزنبقة القديمة إلى بذور تنثرها بعد عام أيضا عندما تتفتح كلفًا بيضاء سَخِيّة. وعبق المكان بعبير عجيب قوي وساحر. ولست أدري لم انبعث بقلبي أسى ضئيل بدا يطفو ليحول الإحساس بالسعادة والبشر الطافحين إلى شعور أقرب إلى الكآبة والانقباض لأمر غامض، لا أدري كنهه ربما ينتظرني بالخارج ذي الألف وجه متسائل في قلب الليل أو ربما في البعيد”184
الصمْتُ المُصْغِي:
بشعرية مضمّخة بالتوهُّم، تصف المؤلفة مغنية أوبّيرا في وضع مَهيب حدَّ القداسة، يكاد فيها الصمت يصغي لفجائية الانقطاع، ويتسلق الهناء في براعم الصمت حتى ليصبح الهناء الصامت والصمت الهنيء وجهان لعملة واحدة تتصادى فيها الصيحة في قرارة الانقطاع، حتى ليتلاشى الصوت والمصوِّت: “كنا في حالة من الانشراح والسعادة الطافحين: المكان يعبق بأريج الأزهار المتفتحة في الخارج على ضوء ممر خريفي.
وفي الداخل كان صوت ممتلئ حياة لمغنية أوبرا شابة جلست في رداء مخملي أحمر وعلى وجهها المستدير المتلقي لضياء المصابيح الخافتة، فبدت كراقصة معبد بوذي جلست عند قدمي المعبود في لحظة تعبد مهيبة. كان صوتها يخرج من بين أسنانها الصغيرة اللامعة وعيناها مسبلتان في استطالة آسيوية، حين شرح الصمت المصغي أو الهناء الصامت صيحة جذلى انقطعت فجأة أيضا حتى حسبت أنها لم تكن وأنّي أتوهم”185
خاتمة وخلاصات:
يبدو أن المواقف المبطَّنة سواء في عتبات النص: (العنوان، التقديم الذاتي والغيري، النص الاستهلالي) أم في متنه أم في استراتيجية تناصِّه، أسفرت عن أن الكتابة لديها ـ بما فيها الإبداعية والفكرية ـ
تغمرها بلاغة الانحياز إلى قضايا تحرر الشعوب186. ولعل التقديم الذي وضعته للرحلة وقد تقدَّم بها العمر، تنمّ عن وفاء لقيم آمنت بها في مرحلة الشباب ـ وهي المرحلة التي كتبت فيها الرحلة ـ وظلت متشبثة بها حتى الرمق الأخير من حياتها187، متفائلة بما يمكن أن تضخَّه في جسد الشعوب التواقة إلى التحرر والنماء.
لذلك جاءت هذه الرحلة مشبوبة بالتفاؤل والأمل والجمال والثقة في المستقبل. كانت لغة الأرقام تنوب أحيانا كثيرة عن العبارة في إسناد التفاؤل المنحاز لجيل الستينات ـ أو سمِّه إن أحببت: الانحياز المتفائل ـ بحركات التحرر الوطني في العالم. طبعا في رحلتها الأولى إلى أفريقيا ـ في ستينيات القرن الماضي ـ
ركزت على حركات التحرر فيها، ثم جاءت الرحلة الصينية لتعزز هذا التوجه بأمل ومحبة وغير قليل من الاندفاع الرومانسي المفعم بالثقة في إرادة الشعوب وتحقيقها للمعجزات غِبّ التخلص من نيْر الاستعمار188. وقد ظلت وفية لهذه التجربة المثالية الرومانسية التطهرية189، التي عاشتها وتماهت معها190 في أتون حركات التحرر الوطني بأفريقيا، وغذّتها بالتجربة الصينية المبكِّرتين. فمنذ أن مزقت (ستار الصمت حول أفريقيا البرتغالية) ما برحت النضال، وهي تعلم علم اليقين أن “القابض على دينه كالقابض على الجمر صامدا في وجه الهجمات الرأسمالية ما بعد الصناعية، على الشعوب في كل مكان في المقياس المدرج”191. كما طمعت في تحقّق حلم الربيع العربي “لعل ربيع العرب يبعث في القلب أمل الستينات والعَشَم في أننا قد نملك كتابة تاريخنا مجددا ونغير العالم وأنفسنا جميعا، خصما على المتخاتلين والصهاينة من كل مِلَّة”192 كل أمل في الانعتاق ظلّ أملا لا يبرحها193، وما تحقق ـ رغم أهميته الجليلة بمقياس التاريخ ـ غير كافٍ لأن أجمل الأيام هي التي لم تُعَش بعد على حدّ قَبَسها من جذوة الشاعر التركي ناظم حكمت (بّوشكين التركي)الذي يقول:
“أجمل الأيام
تلك التي لم نعشها بعدأجمل البحار
تلك التي لم نبحر فيها بعد”.
ملحوظة:
نظرا لضيق الحيز، تعذر علينا إدراج الهوامش، فمعذرة
بقلم: عبد النبي ذاكر