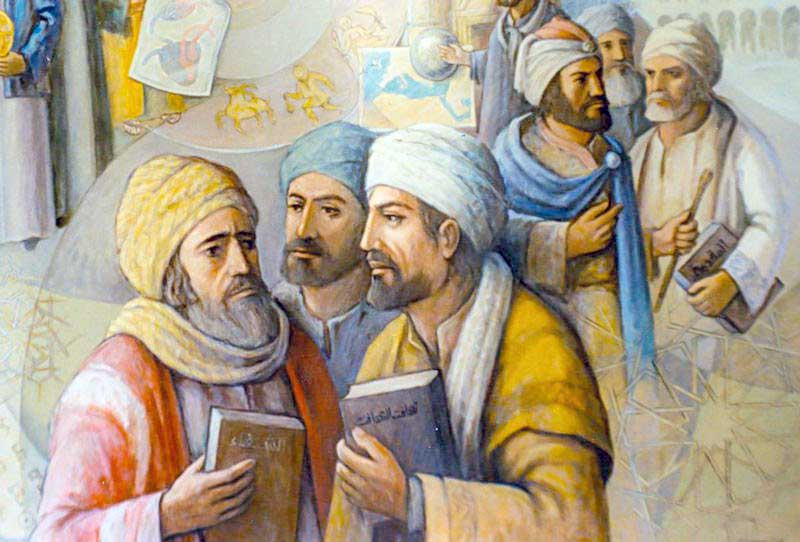منذ أسابيع، اشتعلت نار السجال واشتد أوارها على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأخصائي في التغذية المثير للجدل محمد الفايد وبين عدد من فقهاء الشريعة ببلادنا، بل تخطت هاته «الفتنة» الحدود عندما دخل عدد من علماء وأساتذة الفقه في عالمنا العربي والإسلامي ليدلوا بدلوهم في الموضوع، فالأمر جلل عندما يتعلق بالحديث عن مسائل ترتبط بالمعتقد الديني من قبيل رحلة الإسراء والمعراج ويوم الحساب الأكبر ومصير المسلمين والكفار بين الجنة والنار.. تلك هي المحاور التي تجرأ الفايد على الخوض فيها، خلال مونولاجات تحظى بمتابعة واسعة على قناته على موقع «يوتيوب»، قناة اكتسبت شعبيتها في زمن كورونا بفضل نصائح الفايد الوقائية والعلاجية من الوباء عن طريق نظام يمزج بين التغذية الصحية وأنواع من مغلي الأعشاب.
ولم يشفع للفايد الذي يقول عن نفسه إنه «دكتور دولة ودارس للشريعة وحافظ لكتاب الله ويتحدث سبع لغات»، تاريخه المدافع عن التراث الإسلامي خاصة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن وفي الأحاديث النبوية فيما يرتبط بالتغذية الصحية، حيث وجد نفسه في قلب الإعصار جراء سيل من الانتقادات والهجومات وصل حد السب والشتم والوصم بالزندقة والتكفير.. وزاد من حدة السجال انبراء جيش متابعي ومعجبي الدكتور الفايد للدفاع عنه والرد بنفس أسلوب «المقابلة» على منتقديه. ولم تهدإ العاصفة على الرغم من إصدار الفايد لاحقا لبيان «توضيحي» يؤكد فيه عدم إنكاره للثابت من الدين بالضرورة واحترامه للعلوم الشرعية مع طموحه إلى أن يجمع علماء المسلمين بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية.. استدراك الفايد لم يسلم بدوره من الانتقاد والتمحيص والتدقيق، في إطار فصل المقال فيما يتردد ويقال حول ماهية العلوم الكونية وموقع العلوم الشرعية، وعن أهلية المتحدثين والعلماء المُحدَثين للخوض في مسائل الدنيا والدين…
«الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».. وفتنة الخلاف في الرأي والتشدد له ليست وليدة واقعة الفايد مع علماء الشريعة ببلادنا، بل تكاد تكون رديفة لتاريخ الإسلام والمسلمين منذ وفاة الرسول الأكرم عندما اندلع الخلاف حول من يخلفه في إمامة المصلين وقيادة الأمة الإسلامية آنذاك. ويشهد النص القرآني نفسه على عدد من الوقائع حتى في حياة الرسول حيث احتدم الخلاف بين أصحابه وكان الوحي وحده هو القادر على كبح جماح صراعهم والحافز لإعادتهم إلى وحدة الصف خلف قائدهم رغم ما يفرقهم من عدم اصطفاف في الرأي ووجهات النظر.
كما تعيد هذه الواقعة إلى الأذهان ما تحفل به صفحات التاريخ الإسلامي من حكايات عن الحروب بين «العلماء والفقهاء» المسلمين، كما يصنفهم البعض، على الرغم من أن أغلب علماء المسلمين في الرياضيات والفيزياء والطب يشهد لهم التاريخ أيضا بأنهم كانوا على جانب كبير من التفقه في الدين، وعلما أن عددا من فطاحلة الفقه في تراثنا الإسلامي بدورهم لم يسلموا من تهم التكفير والزندقة. ويسجل التاريخ كذلك أن السجالات التي كانت سببا في «الاضطهاد» والقتل الحقيقي والمعنوي اللذين تعرضت لهما تلك الشخصيات الإسلامية، كانت في نفس الوقت، وهي مفارقة أبدية، عنوانا لحرية التعبير والصراع بين الأفكار في ظل ثورة فكرية وإنسانية عجيبة عرفها المجتمع الإسلامي على امتداد قرون بعد وفاة الرسول، لم يتردد روادها في الخوض حتى في الإلاهيات وفي تحليل النص القرآني من منظور فلسفي.. ولازالت آثار تلك الجرأة الفكرية مستمرة إلى يومنا في تعدد المذاهب الناتج عن تعدد الفرق الكلامية والأقوال الفقهية للسلف..
في هذه السلسلة، نحاول أن نعيد تسليط الضوء على هذا الجانب المثير من التاريخ الفكري للمسلمين، نذكر فيها بشخصيات كانت مثار جدل وصراع اختلط وتأثر فيه التفكير الديني بالمؤثرات السياسية والإنسانية للمجتمع. ثم نعرج لاحقا على بعض ما أنتجه المفكرون المسلمون أيضا من أدبيات ترمي إلى تأطير الاختلاف والحد من أثاره المدمرة على الأشخاص وعلى المجتمع، وذلك في سياق ما أسموه بـ»فقه الاختلاف» الذي أفردوا له جانبا مهما من جهودهم في البحث والتأمل والتأصيل.
أبو حنيفة .. محنة “الإمام الأعظم”
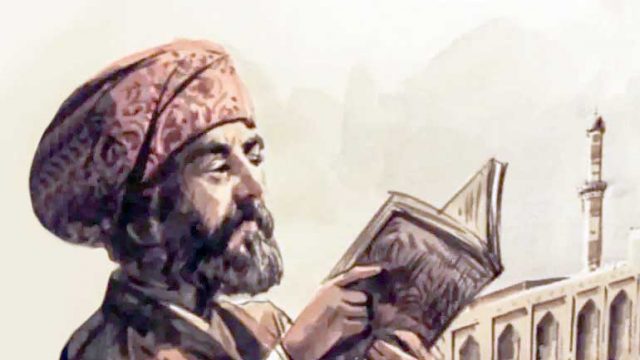
أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزبان الكوفي (80-150 699-767م)، الملقب بـ”الإمام الأعظم”، هو أول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي، والذي يعد اليوم من أكثر المذاهب الأربعة انتشارا في العالم. ويعتبر الإمام أبا حنيفة أول من دون علم الشريعة ورتبه أبوابا ولم يسبقه إلى ذلك أحد كما يقول المؤرخون، ثم تابعه مالك بن أنس في ترتيب “الموطأ”، لأن الصحابة والتابعين كانوا يعتمدون على قوة حفظهم ولم يدونوا أبوابا في علم الشريعة. فلما رأى أبو حنيفة العلم منتشرا، يضيف المؤرخون، “خاف عليه من الخلف السوء أن يضيعوه، فدونه وجعله أبوابا مبوبة، وكتبا مرتبة، مبتدئا بالطهارة ثم بالصلاة، ثم بسائر العبادات، ثم المعاملات، ثم ختم الكتاب بالمواريث. وهو الأمر الذي اعتمده الفقهاء من بعده”.
ولد أبو حنيفة في كوفة العراق، في زمن انتشر فيها العلماء وأصحاب المذاهب والشرائع المختلفة. وقد نشأ أبو حنيفة في هذه البيئة الغنية بالعلم، وبعد أن اشتغل لفترة بالتجارة سالكا طريق والده الذي كان تاجرا معروفا في سوق الأثواب، انصرف لاحقا وهو ما يزال شابا إلى العلم، وصار يختلف إلى حلقات العلماء ويجادل مع المجادلين. ثم اتجه إلى دراسة الفقه بعد أن استعرض العلوم المعروفة في ذلك العصر، ولزم شيخه حماد بن أبي سليمان يتعلم منه الفقه حتى مات حماد سنة 120 هـ، فتولى أبو حنيفة، وهو في الأربعين من عمره، رئاسة حلقة شيخه حماد بمسجد الكوفة، وأخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له من فتاوى، حتى وضع الطريقةَ الفقهيةَ التي اشتق منها المذهب الحنفي. كان معروفا بالورع وكثرة العبادة والوقار والإخلاص وقوة الشخصية. وكان في فقهه على ستة مصادر هي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعرف والعادة.
عرف أبو حنيفة فيما بعد بأنه “إمام أهل الرأي” لكثرة اجتهاده وعمله بالقياس ليصبح بذلك من أول المؤسسين لهامش من العقلانية في النظر إلى الأحاديث إلى جانب النص الأول (القرآن الكريم)؛ فقد كان يقف من بعض الأحاديث والروايات موقف تردد وريبة، رغم قرب عهده من عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ووجود الكثير من التابعين، فكان حين يؤتى بالحديث يقول: “دعونا من هذا”، بحسب ما جاء في ترجمة الخطيب البغدادي عنه، الذي رصد أقوال الكثير من الفقهاء المتأخرين، التي تقدح فيه، وكلها بسبب موقفه النقدي من السنة والحديث. واختُلف أيضا حول خوضه في بعض المسائل الخلافية على عهده من قبيل القول بخلق القرآن من قدمه، وهو ما جر عليه اتهامات بالكفر والخروج من الملة مازالت تلاحقه إلى يومنا هذا من قبل بعض فقهاء السلفية، متبعين في ذلك عددا من أقوال الفقهاء الأولين وعلى رأسهم الإمام البخاري الذي وجدوا في تصنيفاته ذما لأبي حنيفة، وكذلك الإمام مالك وابن حنبل، وعدد من معاصريهم والتابعين الذين كالوا قدرا غير يسير من القدح والذم في الإمام الأعظم واصفين إياه بـ”الجهمي” و”النبطي” و”الزنديق” و”الكافر المرتد”.. وغيرها من النعوث المشينة.
لكن كان هناك أيضا من العلماء والفقهاء من أثنى على أبي حنيفة ودافع عن علمه وعقيدته وعن إعماله للعقل في ترجيح الأحاديث النبوية صونا لعقيدة المسلمين. وقال عنه الذهبي: “وكان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة”. ونقل ضرار بن صرد: “سئل يزيد بن هارون أيهما أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال: أبو حنيفة أفقه وسفيان أحفظ للحديث، فسفيان الثوري كان واسع العلم جدا بالحديث، فهو أمير المؤمنين في الحديث، أما الذي يستنبط ويقيس فـأبو حنيفة فهو أفقه”. وقال الفضيل بن عياض: “كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق، هاربا من مال السلطان”. والخلاصة أن محنة أبي حنيفة مع التكفير مرتبطة بالصراع القديم الجديد بين مدرسة الرأي مع مدرسة الحديث.
وفي علاقة أبي حنيفة النعمان بالسلطان أيضا جانب مهم من محنته، فقد عاصر الدولتين الأموية والعباسية وكان شاهدا على كل التقلبات التي عرفها ذلك العصر. كما أنه لم يكن يخفي أراءه السياسية وموالاته لهذا الفريق أو ذاك، ومن ثم أصبح طرفا في الصراع خاصة على عهد المنصور الذي حاول أن يقرب أبا حنيفة منه لكن الأخير تمنع فتعرض بسبب ذلك للجلد والسجن مرتين، كما يذكر المؤرخون الذين اتفقوا حول وفاته في بغداد واختلفوا حول ما إذا كان قد مات داخل السجن أو بعد خروجه منه.
< إعداد: سميرة الشناوي