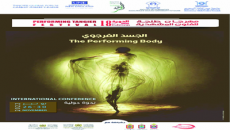إن الإنسان مهما ورث من صفات، فإن الصفات التي يكتسبها من البيئة المحيطة به وعن طريق التربية هي التي تكون صفاته الشخصية وشكلها النهائي، فالإنسان يعيش داخل مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه والحياة هي التفاعل المستمر بين الإنسان ومجتمعه.
وبهذا يكون التبادل أساس حياة الإنسان داخل المجتمع منذ ولادته حتى موته، ويتميز الإنسان عن سائر الحيوانات بقدرته على السيطرة على شعوره والاختيار، هذه القدرة تنمو في مراحل العمر المختلفة، فالطفل في أول مراحل عمره لا يستطيع الاعتماد على نفسه ثم يتعلم كيف يعتمد على نفسه، أي أن الطفل يفقد بالتدريج سلبيته واحتياجاته للآخرين ويكتسب الإيجابية والقدرة على الاختيار وحرية الفعل وهذا هو معنى النمو.
والنمو لا يعني نمو الجسم فحسب، فكما ينمو جسم الطفل ينمو عقله وتنمو نفسه، إن النمو النفسي والعقلي هو حركة نمو مزيد من استقلال الشخصية والقدرة على الاختيار والحرية الشخصية والمسؤولية، هذا النمو ضروري وأساسي ليحرر الإنسان من إرادات الغير ومحاكاتهم، لكن المجتمع بنظمه وقوانينه ومؤثراته وضغوطه يكبت المرأة فيعوق هذا الكبث نموها الفكري والنفسي ويحول دون تحررها من السلبية والاعتماد على الآخرين، وتظل كالطفل في مراحله الأولى من النمو عاجزا عن الاستقلال والإيجابية وحرية الفعل، لكنها تختلف عن الطفل في أن جسمها لا يكون طفلا صغيرا وإنما يكون قد أصبح جسدا كبيرا ناضجا.
ولعل هذا هو السبب في أننا نرى نساء كبيرات ناضجات في أجسامهن أما نفوسهن وعقولهن فلا تزال في مرحلة متخلفة من مراحل النمو، وهذا التخلف هو أهم سبب وراء معظم الانحرافات والمشاكل الاجتماعية أو النفسية أو الجنسية.
إن عدم النضج هو السبب الرئيسي وراء معظم هذه المشاكل، عدم نضج المرأة وكذلك عدم نضج الرجل، فالرجل وإن كان أكثر حظا من المرأة في الحرية وفي فرض النضج إلا أنه يتعرض أيضا لضغوط اجتماعية تعرقل نضجه النفسي والعقلي، كما أن التفرقة الكبيرة بين الرجل والمرأة في المجتمع والضغوط الشديدة على المرأة تزيد من إحساس الرجل بإيجابيته، فإذا بها تتحول إلى مبالغة في السيطرة وميل إلى الأنانية والسادية، (الرغبة في الإيلام)، وتزيد أيضا من إحساس المرأة بسلبيتها لتصبح مبالغة في الخضوع والماشوسية، (الرغبة في استشعار الألم).
إن سلبية المرأة ليست صفة طبيعية في المرأة ولكنها صفة غير طبيعية نتجت عن ضغوط المجتمع وكبته لنموها، وكذلك أيضا جميع الصفات الأخرى التي ألصقها المجتمع بالمرأة والأنوثة كلها صفات غير طبيعية دخيلة على طبيعة المرأة السوية.
وتواجه البنت منذ طفولتها تناقض المجتمع، ففي الوقت الذي تحذر فيه من الرجال وتخوف من الجنس وتفرض عليها العفة، فهي تشجع على أن تكون أداة جنس وتعلم كيف تكون جسدا فقط وكيف تجعل هذا الجسد وتزينه لتجذب الرجل.
وينعكس هذا التناقض على شخصية المرأة بتناقض آخر، فهي تريد الرجل ولا تريده، وهي تقول لا وتعني بها نعم، ويظن المجتمع أن هذه هي طبيعة المرأة وينسى أنه هو الذي فرض عليها هذا التناقض.
وتسبب التربية التي تتلقاها البنت سواء في البيت أو المجتمع كثيرا من المشاكل والعقد النفسية، فالبنت تتدرب منذ الصغر على أن تنشغل بجسمها وملابسها وزينتها طول الوقت ولا تجد وقتا أو اهتماما لتقرأ أو تنمي قدراتها العقلية والنفسية، وتتحمل الفتاة متاعب التجميل وآلامه وتتدرب على أن تخفي طبيعتها وحقيقتها.
وكم تصاب البنات بالقلق والأمراض النفسية المختلفة بسبب حرصهن الشديد على استيفاء مقاييس الجمال الموضوعية، وتشعر البنت أن مستقبلها في الحياة يتحدد حسب طول أنفها واتساع عينيها وامتلاء شفتيها، وهو نفس القلق الذي يصيب الرجل بسبب حرصه على طول عضوه الذكري وفحولته.. إلخ.
وحينما تجد البنت أن أنفها أطول أو أقصر من اللازم فإنها قد تعيش قلقا دائما وقد تشعر بالخجل من أنفها وتحاول أن تخفيه بيدها من حين للآخر بحركة لا إرادية.
ولا يمكن لأحد أن يتصور كم تنشغل البنات بتوافه الأمور، وكم تصبح بضع ميليمترات تنقصها من الرموش عن طولها المعتاد مشكلة حادة في حياة فتاة من الفتيات، وكم من فتاة ترعبها بعض القطرات من المطر لأنها تفسد تسريحة شعرها، وكم من فتاة تفسد مشيتها وقوامها الطبيعي بالتأرجح على كعب عال رفيع، وكم من امرأة لا تستطيع أن تواجه الناس بغير أن تضع على وجهها المساحيق.. وتقلل هذه التربية من طموح البنت وتعتقد أن سنوات الدراسة أو العمل بعد التخرج ليست إلا فترة انتظار تنتهي بالعثور على الزوج.
وينتج عن هذه التربية أن يصبح الزوج هو كل حياة المرأة، أما الزوجة فليست إلا جزء من حياة الرجل، وحيث إن المرأة ترتب منذ طفولتها على أن تنكر الجنس وتكبت رغباتها، فهي تعجز بطبيعة الحال عن أداء دورها الجنسي المفروض مع الزوج وتتهم بالبرود ويصبح من حق زوجها أن يطلقها، أو أن يبقيها خادمة بالبيت وينطلق هو مبيحا لنفسه كل من يستطيع من النساء.
والتربية التي يتلقاها الطفل في مجتمعنا الحديث هي سلسلة متصلة من الممنوعات والعيب والحرام والذي لا يصح ويكبت الطفل رغباته ويفزع نفسه من نفسه ويملؤها برغبات الغير، ويتضح من ذلك أن هذه التربية عملية قتل بطيئة لروح الإنسان ولا يبقى من الإنسان بعد ذلك إلا علاقة الجسدي الخارجي، جامدا فاقدا للحياة، يحركه غيره كما يشاء…
لا شك أن تلك المحظورات والقيود التي فرضها المجتمع على المرأة وبالذات على أعضائها التناسلية قد ساعد على تشويه معنى العلاقة الجنسية، وارتبطت في الأذهان بالإثم والخطيئة والنجاسة، وغير ذلك من التعبيرات المعيبة التي جعلت الناس يخشون الحديث عن الجنس والأعضاء الجنسية وبالتالي أصبحوا يجهلون عنه وعنها الكثير…
وتصور بعض الرجال أن عنق الرحم وهو الجزء السفلي من الرحم الذي يسد فتحة المهبل العلوية هو أكثر أعضاء المرأة إحساسا بالجنس، ويظنون أن عضو الرجل إذا ما لامس هذا العنق أثناء العملية الجنسية فإن ذلك أكبر مؤثر من حيث بلوغ المرأة قمة اللذة.
ناهيك عن الاعتقاد بأن حجم عضو الرجل عنصر هام في الكفاءة الجنسية، وأن الرجل الأقوى جنسيا هو صاحب العضو الأكبر أو الأطول، لأن مثل هذا الطول كفيل بالوصول به إلى عنق الرحم.
ولا يدري هؤلاء الرجال أن حجم العضو لا يدل أبدا على الكفاءة الجنسية عند الرجل، وأن عنق الرحم ليس أكثر أعضاء المرأة إحساسا بالجنس كما يظنون، بل إنه أقل أعضاء المرأة إحساسا بالجنس.. والحقيقة أن عنق الرحم لا يحس شيئا على الإطلاق، لا الجنس لا اللذة ولا الألم، وإن كان أشد أنواع الألم الذي ينتج عن الكي بالنار أو الكهرباء، والدليل على ذلك أن المرأة عندما تصاب بقرحة في عنق الرحم وتذهب إلى الطبيب، فإنه يعالجها بالكي الكهربائي لعنق الرحم دون أن يعطيها أي مخدر ودون أن تشعر بأي ألم.
وقد حرمت الطبيعة عنق الرحم من الإحساس حتى لا تموت المرأة من الألم حين يمرر رأس الطفل المولود من فتحة ذلك العنق الضيق، فالمعروف أن عنق الرحم والمهبل يمنعان القناة التي يولد منها الطفل وأنه لابد لهذين العضوين أن يتمددا ويتسعا ليهبط الطفل بغير ألم، أو بألم بسيط تتحمله الأم الطبيعية، لقد خلق الرحم والمهبل ليخدما الولادة وليس الجنس.
مفهوم العذرية
ندرك أن للمجتمع مقياسين للحكم على الشرف، وأنه فرض العفة على النساء وحدهن، ونتج عن ذلك تلك الظاهرة الاجتماعية الغريبة، وهي أن المرأة تتحاشى الرجل لتحافظ على شرفها، لكن الرجل يطارد المرأة لأنه يريدها، ولأن مطاردتها والاتصال بها لا يعيبه في شيء، ويظل الرجل يطارد الفتاة مستخدما في ذلك شتى الحيل.. مرة الحب الجارف، ومرة الوعد بالزواج، ومرة التفاني في الإخلاص إلى الأبد…إلخ، وحينما تثق به الفتاة وتصدقه يقول عنها المجتمع إنها سقطت في فخ الرجل؛ وإذا غدر بها الرجل ولم يتزوجها يحكم عليها المجتمع بعدم الشرف ويقضي عليها وعلى مستقبلها ومستقبل طفلها. أما الرجل فينطلق سعيدا ناجحا يكرر تجاربه تحت سمع المجتمع وبصره.
أعتقد أننا في حاجة إلى أن نفهم جيدا ماذا نعني بكلمة الشرف، ومن هو الإنسان الشريف؟
إذا كان الشرف هو الصدق مثلا فإن الرجل الصادق يصبح شريفا وكذلك المرأة الصادقة تصبح شريفة.
إن المقاييس الأخلاقية التي يضعها المجتمع لابد أن تسري على جميع أفراده بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الطبقة الاجتماعية…
والمجتمع الذي يؤمن بالعفة في الجنس كقيمة خلقية فلا بد أن تسري هذه القيمة على جميع أفراد المجتمع، أما أن تسري على جنس دون الجنس الآخر أو على طبقة دون الطبقة الأخرى فهذا يدل على أن هذه العفة ليست قيمة أخلاقية، وإنما هي قانون فرضه النظام الاجتماعي القائم.
وقد رأينا في المجتمعات الرأسمالية كيف كان الحكام الرأسماليون يفرضون على العمال والأجراء قيما أخلاقية معينة تضمن زهدهم في الحياة وقناعتهم بأجورهم الضئيلة وخضوعهم للقوانين الرأسمالية الجائرة وتطوعهم في الجندية للدفاع عن مصالح هؤلاء الحكام وأطماعهم الاستعمارية، هذا في الوقت الذي يستمتع فيه الحكام الرأسماليون بقيم الجشع والربح المتزايد والإفراط في كل المتع التي حرموها على الطبقات الكادحة.
وإذا كان الرجال هم السادة في المجتمع فإنهم يدعون النساء إلى الالتزام بقيم الشرف والعفة ليضمنوا خضوعهن على حين ينطلق الرجال مبيحين لأنفسهم الاستمتاع بكل ما حرموه على النساء.
ويخفي المجتمع الدوافع الاقتصادية والاستغلالية من وراء هذه القيم، ويسوق دوافع أخلاقية منها الشرف والفضيلة والعفة. وحينما نسأل المجتمع لماذا يفرض العفة وحدها على المرأة يرد المجتمع بأن هذا طبيعي لأن المرأة غير الرجل، وأن الطبيعة هي التي صنعت كل الفروق بين الرجل والمرأة وليس المجتمع، وحينما نسأله (المجتمع) ما هي الفروق بين الرجل والمرأة، يصيح قائلا إنها فروق ضخمة جدا أحدها أن المرأة هي التي تحمل ثمرة العلاقة الجنسية في رحمها جنينا، ونسي المجتمع أن الحمل والولادة لم يصبحا قيدا على المرأة إلا بفعل المجتمع، حيت قرر أن الجنين الذي ينمو في أحشائها ويتغذى بدمها ولحمها ليس من حقها، وإنما هو من حق الرجل وحده، يمنحه اسمه فيصبح طفلا شرعيا ويعترف به المجتمع، أو لا يمنحه اسمه فيحكم عليه المجتمع بالإعدام وهو لا يزال وليدا يرضع…
يدفعنا هذا القول إلى الإشارة إلى أهمية الكبت المفروض على المرأة الذي يحرمها من الفعل، أو بسبب انفصام بين تفكيرها وفعلها، إنها تفكر في شيء معين وتفعل غيره، قد يكون مناقضا لأفكارها، وهذا ما يدفع القلق الناتج عن الصراع الدائر على الدوام بين هذه الأفكار وبين أفعالها التي تعبر عن هذه الأفكار أو عن عدم قيامها بالفعل الذي تريده.
إن المرأة بهذا المعنى، ومن أجل أن تكون مقبولة في المجتمع تضطر أن تكبت حقيقتها، لذلك تضطر إلى ضرورة التكيف مع المجتمع، وهذا خطر في حقها، حيث لا يمكن أن ينتج عن هذا الاندماج والتكيف سوى قتل لوجودها الحقيقي، والمرأة الطبيعية هي المرأة التي نجحت في قتل وجودها الطبيعي في نظر المجتمع، أما المرأة التي تسمى بالمرأة العصابية، فهي التي فشلت في قتل وجودها الحقيقي ولهذا يقول “رولو ماي”: “كم هو خاطئ تعريفنا العصاب على أنه الفشل في التكيف مع المجتمع، إن هذا التكيف معناه أن يقتل الإنسان الجزء الأكبر من وجوده من أجل الإبقاء على جزء صغير جدا من هذا الوجود.. وأن ما نراه من أعراض العصاب ليس إلا أعراض الإنسان الذي يحاول الحفاظ على إنسانية وجوده…”..
إن القلق هو حالة الإنسان عندما يصارع تلك القوى التي تحاول تحطيم وجوده.
ينتج عن هذا ظاهرة الكذب المتفشية في المجتمع، هذا الكذب الذي يحدث انفصاما بين حقيقة المرأة والرجل أيضا، وبين ما تتظاهر به أمام الناس، والانفصام يحدث في الأسرة أيضا، فيصبح للإنسان حياة أسرية ظاهرية في علاقة الأزواج بالزوجات الظاهرية، ثم حياة أخرى خفية هي علاقة الأزواج بالعشيقات أو الزوجات بالعشاق..
يحدث الانفصام في المجتمع أيضا، فإذا بالتناقض الواضح بين القيم الأخلاقية والدينية وبين القيم التجارية والاقتصادية.
إن المرأة القوية الصحيحة نفسيا المتكاملة البناء في شخصيتها تمثل صعوبة أمام الرجل الذي يريد أن يستغلها لصالحه، ولهذا تفشل النساء القويات الواعيات الذكيات في الزواج، بينما تنجح النساء الضعيفات غير الواعيات في الزواج، وترتفع نسبة الطلاق بين النساء القويات الواعيات الذكيات عنه بين النساء الضعيفات غير الواعيات، ويمجد الرجل في المرأة الضعف وعدم الوعي والغباء والسذاجة، ويلعن الرجل في المرأة الذكاء وقوة الشخصية وتكاملها، ويصبح مفروضا على المرأة أن تخفي ذكاءها ووعيها إذا ما أرادت النجاح في الزواج، وهذا ما يسبب لها صراعا نفسيا.. قد تعالجه بالطلاق أو عدم الزواج (إذا استطاعت) أو تعالجه بالأقراص المهدئة (إذا لم تستطع)، ولا يمكن أن أنكر أن هناك بعض الرجال الذين لا يريدون استعمال زوجاتهم أو استغلالهن، وإذا حظيت المرأة المثقفة الواعية الذكية برجل من هؤلاء فهي تعفي نفسها من هذا الصراع، ولا تكون مضطرة إلى إخفاء ذكائها ووعيها من أجل إنجاح زواجها، ولكن هذا النوع من الرجال قليل وناذر، والأغلبية الساحقة من الرجال لا تزال تفزع من ذكاء المرأة ووعيها، ويفضلون المرأة التي يسهل استغلالها، والتي تستسلم لحياة العبودية دون تذمر أو مقاومة.
فأغلب المثل العليا التي تتمثلها المرأة منذ نشأتها حتى وفاتها، في الإعلام والأسرة والمدرسة والشارع والأفلام والصور والكتب، كلها لا تدفع بها إلا إلى طريق مسدود، إلى الحصول على رجل بشتى الأشكال، والزواج منه بأي شكل وإلا فقد فاتها القطار.
ولهذا تنظر المرأة إلى العمل كأنه محطة انتظار ليس إلا، إذا جاءها عريس غني فهي تترك العمل فورا، وإذا كان عريسها فقيرا فهذا حظها، وعليها أن تعمل حتى تصبح أقل فقرا ثم تترك العمل إذا ما سمحت الحالة الاقتصادية بذلك، وإذا لم تسمح بأن تترك العمل أبدا فهذا حظها ويجب القبول به، وتحسد في أعماقها الرجل الذي يمنعه ثراؤه (رجولته) من تشغيل زوجته مثلما هي تشتغل.
غالبا ما نصادف عند النساء أن العمل والطموح الفكري أدنى أهمية من كل شيء ضروري ولابد أن تنتهي إليه كل امرأة، لأنه مفروغ منه وضروري ولا يحتاج لأي مجهود، وهو الزواج، حيث قليل جدا من يعتبر أن العمل أهم من الزواج، وإن كان الأول يتطلب مجهودا حيا بخلاف الثاني الذي اكتسى أهميته من تقاليد المجتمع والطقوس فقط، من الناذر جدا أن ترسم لنفسها قيمة فكرية وقامة مهمة وعالية في المجتمع، فهذا طموح غالبا ما يتجه إلى الرجال في معتقدهن، لتضطر في مقابل ذلك المرأة إلى إخفاء ذكائها من أجل اكتمال أنوثتها التي تختصرها في طبقة قشرية وهو جلدها الخارجي الذي يحتاج تفرغها من العمل والطموح الفكري، لتجد له وقتا من أجل العناية به بالكريمات والمساحيق التجميلية، وهذا كله ناتج عن المناخ العام والثقافة الذكورية التي تتعرض لها المرأة منذ ولادتها، والدور الذي يفرض عليها، (دور الزوجة والأم) بكافة الوسائل التي توهمها بأن هذه هي أنوثتها وهذا هو جمالها وبالتالي يصعب عليها أن تحارب الطبيعة.
وعلى هذا النحو ترضى المرأة بدورها المفروض، وتتفاخر به وكم من نساء يتفاخرن بأنهن لسن إلا زوجات وأمهات، وأنهن لازلن طفلات وساذجات، وكم من نساء يتفاخرن بتصرفاتهن البلهاء، وكم منهن يتفاخرن بالغباء اعتقادا منهن أنها سعادتهم الأنثوية الكاملة.
وكما يقول “جيته” الفيلسوف الألماني الشهير “Goethe” ليس هناك من هو أكثر عبودية من ذلك العبد الذي يظن أنه حر على حين أنه ليس حرا.
ولا يمكن أن ننكر أن بعض النساء العاملات، (رغم كل هذه المعوقات)، يتفوقن في مهنهن أو يظهرن نبوغا في العلم أو الفن أو الأدب، ولكن هؤلاء النساء قلة قليلة بالطبع، كما أن هؤلاء النساء (رغم كونهن طبيعيات جدا)، يفاجأن حين يجدن أن باب الزواج أصبح مغلقا في وجوههن، وسبب ذلك ليس لأنهن مسترجلات أو منحرفات أو شاذات.. ولكن السبب هو أن الرجال يرفضون الزواج منهن، وإذا حدث وتزوج رجل واحدة منهن، فغالبا ما يفشل هذا الزواج، إما لأن الرجل لا يتقبل تفوق المرأة عليه مهنيا وأكاديميا رغم ما يظهره من العكس تماما، وإما لأن المرأة نفسها بذكائها يصعب عليها قبول العيش مع تافه ذي عقلية مغلقة.
إن لعب الرجل دور السيد الذي يخضع المرأة من خلال استعبادها واستغلالها وتحويلها إلى أداة يعوض من خلال كل ذلك قهره ومهانته، حيث تموت نفسيا من خلال اعتبارها كأداة القهر والمهانة من أجل ضمان وهم الحياة له…
إن هذا التناقض الذي يعيشه الجنسان معا بالقول، في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة، يقع العزم على المرأة دائما، فهي مذنبة إن استسلمت للإغراء قبل الزواج ومذنبة إن حرمت المتعة برفقة زوجها نظرا لما يتعرض له جسدها من قمع، ومذنبة إن لم تنجب الذكور، حيث تتحمل الوزر كله، كما يتحمل الرجل الكادح الوزر كله في حياته اليومية (هو الجاهل، الكسول، غير المنتج،..)، إفلات الرجل من المسؤولية والمحاسبة هو كإفلات المتسلط والمستغل والإقطاعي بالتمام، هكذا فإن علاقات الرجل الجنسية مع المرأة تسودها الأنانية الذاتية، إنه لا يفكر إلا بنفسه ومتعته، والمرأة ليست إلا أداة لهذه المتعة، تماما كأي علاقة اشتغال الرجل الكادح، فهي مجرد آداة للغني. وكما يتخذ الرجل من ضعف المرأة مبررا كي يستغلها، كذلك يفعل الإقطاعي بالفلاح العاجز الذي لا يصلح في زعمه إلا للعمل المضني.
فالمرأة تريد أن تنطلق ولكنها لا تجرأ على طرح قضيتها جذريا، والحق يقال إن الرجل لا يشجعها على هذا الطرح الذي يضعه هو في المقام الأول موضع تساؤل، ولابد أن يدفع به إلى إعادة النظر بوضعيته وأسلوب علاقته به، فالرجل يتحدث عن المساواة وعن تحرير المرأة ولكنه لا يستطيع التخلي عن امتيازاته بسهولة، وهكذا يعاني كل منهما من صراعات نفسية وتناقضات داخلية وعلائقية، فهي ما زالت محافظة مقيدة داخليا مع تحرر ظاهري وهو مازال متمسكا بوضعية السيد وامتيازاته مع ادعاء المساواة والانتصار لحقوق المرأة.
نجد في مقابل ذلك أن المرأة تخشى الإقدام على تحمل مسؤولية مصيرها وفرض ذاتها لما غرس في نفسها من مخاوف بغية إبقائها في حالة تبعية، كما أنها تخشى أن يسيئ فهمها الرجال الذين لم يعوا بعد ضرورة تحررها، أو الذين يحرصون على امتيازاتهم.
أما الرجل فمعاناته أكثر، فهي ليست بدروها بالبسيطة، فهو متحرر فكريا وثقافيا وهو من أنصار المساواة ولكنه ينتظر أن تقوم المرأة بذلك دون أن يشارك فيه بشكل فعال والغالب أن يكون حماسه نظريا، أما في الممارسة اليومية التلقائية، فما زال أسير التقييم العبودي للأدوار، ما زال شديد الحساسية لكل ما يمكن أن يعتبر نيلا من سلطانه وحقوقه على المرأة.
وهكذا فأكثر الرجال تحررا ما زال عمليا يتصرف انطلاقا من توزيع للأدوار، يعطيه بعض المكاسب، ويشد المرأة إلى الوراء ويتصرف خصوصا من موقع تجنب وضعية امتحان قدراته الفعلية، ووضعها موضع تساؤل، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فنجد انقلابا في الأدوار بين الرجل والمرأة إلى أساس طفلي قوامه علاقة الطفل بأمه كينبوع كل عطاء ومصدر كل متعة، ينكص الرجل المحروم جنسيا إلى مستوى الطفل المتلهف إلى حنان الأم وحليبها، وتحس المرأة هذا الواقع مما يمدها بمشاعر الانتصار، فهي التي تعطي أو تمنع.
تستخدم المرأة هذا السلاح من الحرمان كي تستمد منه أهمية واعتبارا يعوضان لها قهرها، لكنه تعويض زائف، وهكذا فهي تحول التحريم الذي فرضه الرجل على جسدها وعلى حرية تعبيره عن رغباته إلى سلاح للسيطرة عليه، تلك واحدة من مفارقات وضعية القهر، وتتدرب المرأة على ذلك منذ نشأتها بفعل بؤس المحيط، فهي لعبة ماتعة تغطي حرمانها الجسدي والجنسي من خلال تعبيرها الجسدي الذي يعد ويمتنع، يجذب الرجل ويفلت منه… ولكنها لعبة مرضية ليس فيها سوى وهم الإشباع ووهم إرضاء الجسد والنفس.
هناك تضخم نرجسي يحمل تعويضا هاما للمرأة خصوصا في المجتمع الاستعراضي من خلال المظهر، كالتوظيف العاطفي والجنسي الذي يحدث عند المرأة بالنسبة إلى استخدام الملابس والزينة وهي ظاهرة ليست بحاجة إلى برهان. وهكذا تتباهى المرأة بلعب دور عارضة الجاه والثروة من خلال ما تلبس، وما تتحلى به وكأن جسد المرأة لا يتضمن قيمة كافية بحد ذاته، فهو بحاجة إلى الأدوات والأمتعة من كل نوع كي تخفي قصوره، أو ما أسقط عليه من نقص، وهنا أيضا يزين كيان المرأة، وتزيف عواطفها الحقيقية من خلال تحولها إلى آلة استعراض، تعتز بهذا الدور لدرجة يلهيها عن القيم الذاتية والإثراء العاطفي والعلائقي…
تلك أمثلة سريعة عن تعويضات تجد المرأة لنفسها قيمة ذاتها من خلالها وتدفعها إلى التمسك بها، ولكنها تنسى أن هذه التعويضات تدخل جميعها ضمن حالات الاستلاب الذي تتعرض له جنسيا وعقائديا.
السيطرة غير المباشرة على الرجل
من أشهر ما تلجأ إليه المرأة هو التنغيص الذي تتفنن فيه بعض النساء، فتطارد الرجل بلا هوادة حتى تسمم حياته، وتقضي على سكينته، وتثير في وجهه الصراعات لتخرجه عن طوره وتدفع به إلى الهروب بعيدا عن العلاقة الزوجية التي فرضت عليها العبودية، أو تدفع به إلى فقدان سلطته المعنوية في الأسرة من خلال حشره في سلوك عدواني يدينه في المقام الأخير، ذلك أيضا محتوم بما تفرضه عليها وضعيتها من استلاب وجودي حرمها تحقيق ذاتها، ناهيك عن أساليب الاحتماء بالمرض أو اللجوء إلى محاولات السيطرة الخرافية على المصير من خلال السحر والشعوذة والأولياء والكتابات وغيرها، تلك هي درع الحماية الأخيرة يلازمه عادة الدفاع من خلال التماهي بالرجل المتسلط وإدانة الأنوثة التي تلجأ إليها المرأة في وضعية القهر المفرط.
تتنكر لذاتها كامرأة معبرة عن القصور في حالة من الذوبان في الرجل كقيمة وحيدة.
نستنتج أن دفاعات المرأة السابقة تذهب جلها في اتجاه مرضي، لأنها وليدة علاقة مرضية بين الرجل والمرأة (علاقة التسلط والقهر)، وهي دفاعات لا تفسح مجالا أمام بروز علاقات معافاة تحمل الإثراء المباشر والمتبادل لكل من الرجل والمرأة، ذلك مستحيل في وضعية القهر، لأنها تنخر إنسانية الإنسان في العالم المتخلف وتلقي به في كل أشكال الاضطراب والاختزال، ولا يمكن في هذه الحالة أن يصل إنسان هذا العالم إلى التوازن النفسي وإلى الشخصية المعافاة والمتوازنة، إلا إذا تحرر من وضعية القهر التي تفرض عليه، لا يمكن للرجل أن يتحرر إلا بتحرر المرأة، ولا يمكن للمجتمع أن يرتقي إلا بتحرر وارتقاء أكثر فئاته غبنا، فالارتقاء إما أن يكون جماعيا عاما، أو مجرد مظاهر وأوهام.
توصلت الدكتورة نوال السعداوي إلى خطأ التحليل الذي توصل إليه فرويد وزملائه من العلماء الذين ذهبوا بالقول إلى أن نسبة قليلة جدا من النساء من يظهرن عبقرية في الفن أو الأدب أو العلم؛ حيث تذهب الدكتورة أن سبب هذا الخطأ يكمن في تجاهل الظروف الاجتماعية التي تفرض على المرأة الانغلاق داخل جدران البيت، وتضييع الوقت في خدمة الآخرين والغسل والطبخ، وأرجعوا ذلك إلى الفروق التشريحية بين المرأة والرجل وبعضهم أخرج نظرية تقول، إن قدرة المرأة على الخلق تمتصها بيولوجيا وظيفتها كأنثى تحمل وتلد، بمعنى أنها تخلق أطفالا بولادتهم، ولذا لا حاجة لها إلى الخلق في مجال آخر، كالفن والأدب… وحيث إن الرجل لا يلد فإنه يستطيع أن يخلق في مجالات أخرى، لهذا كان بديهيا أن يتركوا للمرأة الوظيفة البيولوجية وهي الولادة كسائر الحيوانات.
وهذا ما وضحته الدكتورة بالقول إنه بالرغم من حرية المرأة إلى حد ما بعد كل أنواع القمع، حيث لم يعد هناك حزام عفة حديدي، لكن تؤكد أن أثر الحزام لا زال موجودا، بل إن المرأة تصنع الحزام خوفا من تلك الحرية الجسدية التي لن تتعود عليها، وهي في الحال أشبه بالسجين الذي قيدت قدماه بالسلاسل الحديدية سنين طويلة، وحين رفعت السلاسل أصبح خائفا من مجرد السير على قدميه… والمرأة أيضا أصبحت تحب قيودها، وليس ذلك بسبب الفروق التشريحية بينها وبين الرجل، ولكن بسبب القهر الاجتماعي الطويل، وخوفها الدفين الآن من أية حركة أو حرية. حيث لا يسمح المجتمع للمرأة بالعمل إلا بشرط ألا يتعارض عملها مع واجبها الأول في الحياة (زوجة / أم)؛ وإذا تعارض فلا بد لها أن تعود فورا إلى البيت وإلى دورها الأول، بل إن خروج المرأة للعمل ليس (في منطق المجتمع) من أجل أن تنمي قدراتها الفكرية وترضي طموحها الإنساني والفكري، وإنما من أجل أن ترفع المستوى الاقتصادي للأسرة…
نستطيع من خلال قراءتنا في العلوم الأخرى غير الطب والتاريخ والأدب أن نفهم كيف ولماذا فرضت القيود على المرأة..
هذا إضافة إلى أن تجربتي الخاصة كامرأة تزودني بحقيقة أحاسيس المرأة العميقة وما أحوج العالم إلى معلومات صحيحة عن المرأة، تغير المفاهيم الخاطئة التي أشيعت عنها في العالم، والتي كانت تكتب في معظم الأحيان بأقلام الذكور.
< بقلم: جهان نجيب
أستاذة باحثة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر.