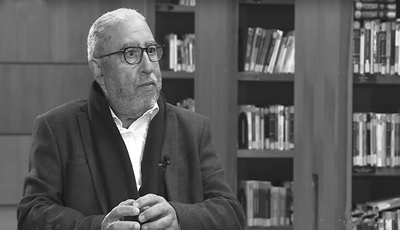– 1 –
سّي محمد، مساء الخير. الآن وأنتَ تقفُ على مسافةٍ كافية من إكراهات المنصِب والسياسة، وتَحَلُّلِكَ النهائي من الحِزبي والرسميّ، أستطيع أن أخاطبك، أن أكتُبَ لكَ هذه الرسالة – التحية، أو بالأحرى يمكنني التوجُّه إليك هذه المرة كشاعر بالأساس، كنتُ قد التقيتُ مع جُلّ قصائده ودواوينه منذُ: “صهيل الخيل الجريحة”، “عينان بسعة الحلم”، يومية النار والسفر”، “سيرة المطر”، “مائيات”، “يباب لا يقتل أحدا”، “كتاب الشظايا”، “سرير لعزلة السنبلة”، “قصائد نائية” إلى “حكايات صخرية”… حيث يتقاطع صوت الشعر بعنف المرحلة (السبعينات وبداية الثمانينات). وما طبَع إنتاج جُلّ شعرائها القريبين من الالتزام السياسي، آنذاك، من مفاصل كبرى تَحكُمها أساسا موضوعات: العشق والحلم والفجيعة والعزلة والغياب والتمرد والتشظي والنضال السياسي والعديد من الأسئلة الحارقة حول الوطن كقضية مركزية.
موضوعاتٌ كانت قد وشمَتْ، وبشكل ملفت، ذاكرةَ العديد من الشعراء والكُتّاب والمبدعين في مختلف مجالات الإنتاج الرمزي، والمنتمين إلى مرحلة ملتهبة وضاغطة من التاريخ السياسي المغربي، إضافة إلى ما كان مطروحا أيضا، حِينها، من قضايا أخرى كانت على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لشعراء الالتزام، في المغرب وغيره من أقطار الوطن العربي، عَكَسَتهْا نصوصُهم الشعرية بشكل أساس: كالقضية الفلسطينية وهموم الوحدة والقومية العربية وغيرها… هي النصوص والقصائد التي جاءت “شاهدةً على المرحلة”، أو كوثائق شعرية تؤرخ لجراحات الذات والوطن وإخفاقاتهما المتكررة.
سّي محمد، أنتَ شاعرٌ وسياسي عايشَ جسديا ووجدانيا كل أحداث هذه المرحلة، مما جعلها تنحفر وتترسخ في عمق ذاكرتك كوشوم دامية يصعب التخلص من عُنفها الرمزي. ولو أن تجربتكَ الكتابية متعددة الأبعاد والأضلاع والأجناس، بما فيها الشعر كإنتاج مركزي، (حيث ستأتي فيما بعد تجربتُكَ السردية المميزة في القصة والرواية مع بداية التسعينيات) لم تكن مرهونة، في مُجمَلها، فقط بقضايا وأمور السياسة والإيديولوجيا، (كذلك فعَل العابر الهائل “محمود درويش” حين لم يجعل تجربته الشعرية مرهونة في كُلّيتها بالقضية الفلسطينية، إذ فتحها على الحب والموت والحياة وأشياء أخرى شخصية وذاتية)، بل امتدتْ هذه التجربة الكتابية عندكَ إلى حقول أخرى، لا تَقلُّ أهمية عن الشعر والسرد: تجربة الصحافة وكتابة الرأي: عَمُودكَ المائز والشهير “عين العقل” بجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، يومَ كانتِ “الوردة” في أوج وكامل نضارتها وعنفوانها!
مع ذلك، ولو أنكَ ابتعدْتَ عن كل شيء سوى الكتابة، فأنتَ كذلك الشاعر والكاتب الذي تعَهّد “الوردة” بالكثير من المحبة والعناية والتضحيات والمكابدات. حاولتَ بما تستطيع وبما في وُسْعِ يدكَ أن تُخَصّبَ تُربتها وتسقيها بماء الكتابة والتواجد الميداني، بالرغم من اختلاف الرؤى والمواقف والمواقع بينك وبين رفاق النضال أو رفاق الأمس، كل الرفاق الذين رحلوا أو صمتوا أو انسحبوا مُجبَرين، أو عن طيب خاطر إلى مَجْدِ عُزلتهم الشيقة حسب “منطق” أو مقولة “أرضُ الله واسعة”! هكذا كان انسحابكَ من “مشروع “الوردة” اختياريا بالأساس، هو المشرع أو “الحلم” أو “الأمل” أو “الأفق” الذي لم يتحقق على أرض “السياسة”، وقَررتَ، إلى جانب بعض الرفاق، مواصلتَه أو، بالأحرى، نَقْلَه إلى أرض الشعر والكتابة؟
ذلك ما حصل لكَ أيضا، كما بالنسبة للعديد من الشعراء والمثقفين والكُتّاب المغاربة، المنتمين إلى مرحلة المخاض أو الغليان السياسي لمرحلة السبعينات وبداية الثمانينات في المغرب، سواء كانوا في قَلْب ِالعمل والممارسة السياسية أو خارجها، حين وجدوا أنفسهم أمام انسداد عام في الأفق، وأمام فشَلِ ذلك المشروع الجميل والمشتهى في التغيير وتحقيق غد محلوم به أيضا لوطن ولأمة عربية كانت تُشحن بأدبيات ومقولات المد الشيوعي واليساري من جهة. ومن جهة أخرى، تجد نفسها في مواجهة قوى وأنظمة ضاغطة ورافضة لكل تغيير سياسي واجتماعي واقتصادي؟
وسيحصل من دون شك، بدافع هذه الصدمة أو الحلم المُجهَض، تَحَوُّلٌ نوعي، إن لم نقل جذري في الرؤية لديكَ ولدى هذا الجيل. وسيبدأ النزوح نحو خطابات أخرى بديلة، أو التخلي تدريجيا عن مشروع أو يوتوبيا التغيير الكلي لصالح رؤى وآفاق أخرى (تعبيرية وجمالية) تحتفظ من مشروع المقولات والشعارات السياسية الكبرى بجوهرها وعنفوانها فقط، لكن سيتم تصريف هذا الجوهر وهذا العنفوان، بعيدا عن السياسة، إلى لغة أخرى… وستنتصبُ هذه الآفاق التعبيرية والجمالية بدورها بمثابة ملاذات أخرى، سيَلجُها جيلٌ بأكمله من المبدعين المغاربة بقاموس مغاير: دعامتُه الكبرى الأسئلة الأنطولوجية أو الوجودية الحارقة، وعناوينه الأساسية: الحُلم والعشق والكثير من الأشياء الأخرى التي تجعل الحياة مستمرة وممكنة؟
بذلك، ستتحول الكتابة عِنْدَكَ وحْدَها، بإمكاناتها الهائلة في جَعْلِ الذات الشاعرة والكاتبة تتخطى، ولو رمزيا، انكسارها وانهيارها أو صمتها القسري، إلى ملاذ أخير وإلى نوع من التنفيس الممكن، ثم إلى وسيلة حقيقية للتعويض، يُشَكلُه هذا الأفقُ الشاسع والرحيم للانفلات والهروب من ثقل المرحلة وضغطها، ثم إلى نوع من المقاومة الذاتية، تجنبا للفجيعة والسقوط. مِنْ هنا، ستتواصل وتبدأ عندكَ، داخل وخارج كل تلك المسارات الشاقة والمضنية كلها من رحلة البحث عن الوجه المتمنّع للذات والوجود والوطن المحلوم به ووجهه العصي على القبض، رحلةٌ أخرى يحددها، بالنسبة لشاعر وكاتب وسياسي، تَحَوّلٌ نوعي في الرؤية وأسلوب الكتابة الشعرية: رحلة ستحاول الكتابة فيها تخطي مطلبها المادي والسياسي المباشر، نحو المطلب الجمالي والروحي، بل الفكري والتأملي أيضا: البحث عن الحقيقة في كل شيء. في الموقف والرؤية والوطن والتاريخ والكتابة والتباعد بين رفاق المسار. خصوصا وأن العُمر والجُهد لم يعودا، بَعْدُ، قادرين على تَحَمُّلِ المزيد من ارتهانات الجسد والتزامه بالمعارك وصخب الساحات واشتراطات المشاريع النضالية الكبيرة.
ستأوي الذات الشاعرة والكاتبة إلى ملاذاتها الرحيمة كلها، والتي تكون الكتابة بداخلها هي الأساس وحَجَر الزاوية، هذه السماء الفسيحة أو الشجرة الظليلة التي وحدَها لها القدرة على إيواء الشاعر وظله. ستؤول الذات إلى عزلتها المجيدة، على الأصح، وإلى أمكنتها وملاذاتها الحميمة: سواء كانت هذه الملاذات: قصيدة أو نصّا أو سَفَرا أو مقهى أو امرأة أو حتى لحظة متعة عابرة: فقط لتعيد عرض شريط الذاكرة بالمقلوب وترتّب معناه. لتَكتُبَ وتُسائل وتُحاور وتتقصى وتُدَوّن شهادتها على الانكسار أو وثيقتها “الشاهدة على العصر” وعلى المرحلة؟ مع ذلك كانت الكتابة وستظل بالنسبة لكَ، فيما أعتقدُ، مسؤوليةً وليست مجرد ترف جمالي أو فكري.
-2 –
وإن كنتُ، هنا، قد اخترتُ سبيل “الشهادة” والتحية عوض قراءة ممكنة في أعمالك الشعرية، قراءة تليق بالمكانة المميزة التي تحتلها تجربتُكَ الشعرية في المشهدين الشعريين المغربي والعربي، فذلك لأنني أردتُ أن أنقُل إليكَ وأشاركك الكثير، بل المزيد من الأسئلة، ليس حول الشعر وقضاياه التعبيرية والجمالية من منظور نقدي (لكوني مقتنعا بأن الشعراء، غالبا ما لا يعثرون على ملامحهم الحقيقية فيما يُكتَبُ عنهم من دراسات ونصوص نقدية)، بل من باب وظيفة ووضعية ورهانات هذا الشعر الآن، في المغرب وفي غير المغرب (الوطن العربي من الماء إلى الماء على وجه التحديد)؟ هي الأسئلة التي تسكنني وتؤرق مضجعي منذ أن قررتُ بدوري أن أكتُبَ أولَ قصيدة. هذه ومضاتي وإشاراتي وأسئلتي الحائرة إليك بعين تُشَوّر خَلْفَ القصيدة، لعلّكَ تلتقطها بحواسك الخبيرة بالسياسة والشعر، ما دام الشعر بدوره غير بعيد عن السياسة، كما قد يعتقد البعض؟ وما دامت تجربتك الشعرية والكتابية برمتها لم تستطع السياسة تدجينها، ولم تتعال عليها في نفس الوقت، بل قامت بترويضها وتفكيكها وتشفيفها إلى الحد الذي تختفي معه تلك الفروقات وكل تلك التدرجات Les nuances بين القصيدة والإيديولوجيا.
– 3 –
حين كانت سُلطة الشعر أوكَدَ من سلطة الرصاص، وحين كانت القصائد السياسية، على سبيل المثال لا الحصر، لشاعر من عيار “بابلو نيرودا” توقظ وتُلهِم وتُشعل الحماسة الثورية لشعب بأكمله (الشيلي)، بل قارة بأكملها (أمريكا اللاتينية)، أسمحُ لنفسي، هنا أيضا، باستعارة القولة الشعرية الشهيرة للعظيم “المتنبي”، لكنْ مع بعض التحوير الخفيف في الصياغة والأداة، وأقول: الشعر “أصدَقُ أنباءً من الكتُب”، إذ تكون هذه الإشارات أو هذه الومضات الملتمسة ليقين أنتَ تفهم كنهه، ودروب جارفة نبضُكَ أعلم بمسالكها الوعرة، هي رجع آخر من رجوع المتون المعرشة أسفل الروح، اقتراب مَوْجُول من هزة الشعر وترددها، تَوجُّسٌ مفتونٌ بمَحَجَّته الخلفية، تحرسه وتضيئه خطفات الوله العميق وأتُونه المشتعل، هي أيضا بعضٌ من الغصة والتَّوق المكتوم، وتحية خاصة لكَ كما ترى أيها الشاعر المجهَضةُ أو المؤجَّلةُ أحلامُه، يؤازرها في النهوض احتمالكَ الصاعد من زمن السؤال، ما دام “السؤال هو رغبة الفكر”، على حد تعبير الناقد الفرنسي الاستثنائي “موريس بلانشو”؟ هكذا تتواصل عندكَ، في تجارب الكتابة والحياة، مَشاهدُ الحَفْر والكتابة، وأنتَ تُكلّمُ العناصر (الماء والنار والحجر والتراب). فبين الشعر والتنقيب عن صوت العناصر معابر سرية، تَربط الجسدَ بمنطوقه، تَمنح الأعضاء الهائجة شَغفَ الكلام وتُسْمِعُ صوتَها المرتجّ!
– 4 –
وبما أن أول الشعر دهشةٌ، فهو كذلك روح الحياة وبهارها، نشوة الكلام ودهشته الجميلة، ينير كعادته منذ الأناشيد السومرية القديمة سراديبَ القلب واللغة والثقافات، يجوب أقاليم الزمن مُجلجِلا، مستشعرا آلام الروح وأعيادها، يُدوّن بالرعشات رغباتها المنسية، يَرسُم في سماء الباطن شُهُبا تمُرّ ولا تنقضي، كذلك كانت القصائد الأولى والولَه الأول. عندما يَرقُص الشاعر يرتعشُ العالَم، ومَن يسأل الراقص عن دوافع الهيجان، يُدرِك بأنّ الرقصَ تعبيرٌ أسمى، احتدامٌ لنصوصٍ عالية الضغط تُزوبِع لحظةَ الكائن وتُحرر الجسدَ من شَبَقِ الجسد.
– 5 –
طالما حيرتْني مِسْحَةُ ذلك الحزن الغامض الذي يُسربل وجوهَ الشعراء، تجذبني الرهبة التي تسكن أطيافهم الهاربة. طالما اعتقدتُ بأن الشاعر واحد من الأنبياء، وأن وجْهَه مثل يده الرائية شكلٌ لعُملة واحدة، تتجاوب بينهما لذائذُ الروح ومسافاتٌ من المواجع والحنين، ينضج الجسدُ برنين العصور السحيقة، والشاعر من ينبغي كتابةَ هذا الرنين. الرقصُ كما الولَه، قصائدُ باقيةٌ، ومن يبحث في القصائد عن معنى قد لا يجد المعنى، في الشعر لا يوجد غير الشعر. لِنبتَهِجْ: فقمة المِحنة أن تُسأل عن علاقة الرقص بالشعر؟
– 6 –
الشاعر الحقيقي بطبعه كائن حرائقي، ومِنَ الشعراء من يحمِل مصيره بين يديه، والأنامل وجْهٌ آخر للاختبار، تاريخٌ شخصي، يَحْمِل مجْدَه أو هاويته، يد الشاعر، مثل لسانه، قاصمة، تشبه حدّ السيف، كما العرّاف يجعل يده رائية أيضا، ويمنح للعِبَارة لمعانها الخالص. لا يركن الشاعر إلى بريق الأسماء ولا يركَب عبثا زبدَ الكلمات، يَدعُ البريق لأصحابه ويجترح للحريق معبرا بين أصابعه. لا تستحقُّ الرهبة لحظتهَا ما لم يمتلئ قلبه بجلال اللحظة.
– 7 –
أنْ يكونَ المرء شاعرا، فذلك اختيار صعب، فكيف تبحث رئة القصيدة عنده عن نفس نقي، عن هواء لم تطله بَعدُ نَعرات السَّبق ووصايا المحبطين؟ هل له أن يكون فقط للسيادة، للسؤال في كل شيء، للعصيان الخلاق، للأبدية ولانجرافه الداخلي حتى يَبْلُغ ألقَ الموتى وبلاغتهم؟ وأن يختار ما يُرعش كل سريرته ويدهشها؟ أن يكون لاختياراته فقط ويخترقْ زمنا تتهافت فيه الجموع على الغُبار، على امتداح الخرابات وتمجيد عطائها السخي؟ لا يكون الولع ولعا ما لم يُسْلكْ كمصير شخصي، المولوع من يحترف أخطارَ المعشوقة كاملة.
– 8 –
قال “شكسبير” العظيم على لسان الأمير “هاملت” في العبارة الافتتاحية من مناجاته الفردية في مشهد “الراهبات”: “أكون أو لا أكون To be or not to be؟”. في زمن الشعر الحقيقي وليله الهادر، كانت القصائد تُشعل عنفوان القلب ورُقَعَ التراب، تُنير وجعَ قارات بأكملها وتسرق النوم من جفون الجلادين، فما للشعر أصبح ينأى عن الشعر وعن عنفه؟ والشاعر أصبحَ أكثر عزلة عن سيَّافه؟ ليس لغير هذا المقصد ينبغي أن يقوم الشعر، وأن يداري الشعراء سَقْطتهم بشيء من الكبرياء، ويستبدلون صمتهم بصمت آخر، أقل مرارة فقط: إنّ الشعر مثل باقي حلمنا، إما أن يكون لنا أو لا يكون. ليس الظل ما تعكِسه الأشكال، بل ما تُسقِطه الظلال نفسُها بعد فَناء الأشكال.
– 9 –
تِباعا، تتداعي دون الشعراء معاول القبائل ومعاقلهم، وقليلةٌ هي الأصوات التي ظلتْ وفيةً لقناعاتها ولدمها الشخصي، تقاوم تغييبها في شرنقة الأنساق، وتمسح كلما استبَدّ بها الشوق، مشهدَ الصمت أو الخراب الممتد من الشعر إلى الشعر. هو وجهٌ آخر من وجوه المحنة وتجلياتها، تمتحن فيه القصيدة بعضَ غيابها المحموم، ثم تركن مُجبرةً إلى صمتها الفاجع. لعله النشيد يَصعَد من قلب الأنقاض؟ يزيل غشاوات المرحلة ويعيد للصلوات الآتية عُمقَها المسلوب، ويمنح للخطر نضارته الأولى؟ أو لعله صوت البداية ينبئ بنكوص آخر؟ وما مِنْ أحَدٍ، غير الشعراء يَسمع صوت البدايات. ليست بعيدةً قلوبُ الشعراء عن فِكرهم، فلينصتوا إلى أشكال مناجاتهم السرية، وليربطوا كل ذلك بسؤال رفيع: هل من أحد ما زال حقا يستحق هِبةَ الشعر؟
– 10 –
ولو في إقامته الحائرة، ليكن هذا الشعر مثل تربته، سؤالا ما عاد يحتمل التأجيل، ونحنُ كما نحنُ، ما زلنا مقيمين، في اللامكان، نقرض خيْبات الوقت ونُمنّي النفس بالأمل المحجوب، نهادن رعشاتنا ومصائرنا الكبرى في انتظار بزوغ القمر. قَصيٌّ هذا القمر كما يبدو، قريبٌ ضوؤُه لكنه مُتمَنّعٌ كما وجهه اللعوب، يمنحنا بهجة مفاتيح اللغز، ويجلس عند الجهة الأخرى مثل أبي الهول، من طرف المتاهة ومسافة الرد، يمتحن فينا القدرة والسؤال. ربما علينا الآن لكي نَعبُر هذا الترقب أن نستبدل فينا الكلام بسيادة الكلام؟ وحدَها هذه المجازفة بوسعها أن تمنحنا ــ نحنُ المتأرجحون على حبل السؤال ــ توازننا المطلوب، وتجعلنا مثل الطائر الخبير نتمايل ولا نسقُط. ليس قريبا اسمنا من كياننا، يَحدُثُ أن تلتهم الغربة مسافة الألفة بينهما، لنُعلّم أنفسنا لعبة فقدان الأسماء!
– 11 –
ليكن هذا الشعر كما البلد الذي ما عُدنا نَعرِفه، يَغيب ويحضر فينا كل لحظة، يغور وينجلي، منفلتا، كلما حاولنا ملامسة تواريخه الممكنة، خرائطه السرية، الممتدة في هوسنا إلى أبعد من زمن التكوين ودليل الميلاد. وهذا الجسد المُسْهَد الذي نحياه على مضض، على نشوة العبور إلى ممكنه الشعري، أصبح مترهلا، ملتبسا، محمولا على محفة الصمت، والرغائب فيه كما المصائر ما زالت محروسة بسدنة الهياكل والمتعاليات. مُرتَحِلٌ هذا النشيد المضيء ومؤجل في لوعته، مُوزَّع في تَوجُّسِه بين المصالحة وتجميل المَناحات، تُفتح في الجهة الواحدة من صعقه المتصدع أسواق لبيع الهباء، منصاتٌ افتراضية ًتمنح رخص الكتابة والكلام، وتوزع الألقاب والمدائح بينها بسخاء نادر. أصبح للأوهام موزعون محترفون يشتغلون علانية، يهَبون الروح أحقادهم، غشاوتهم ويقيمون أعراسا للدَّمار. ليس الجلال بما ينثره الآخرون على شخوصنا من نعوت، بل بما تؤتيه جسارة أرواحنا. لنُحَصِّنْ أنفسنا وأعماقنا من لمعان البيارق والألقاب، بوسعنا عندئذ أن نكون أجِلاّء!
– 12 –
ما تبقى من الشعر ــ هنا وهناك ــ تأكله العزلة واختيارات المنافي، يبدو متعذرا وغريبا، قانعا بأشغال الفراغات المبجلة ومُدبَّجا بالهالات المشيَّدة حديثا، فائضا عن حاجته اليومية، لا يلوذ به الشعراء أنفسهم، نادرا ما يتجاوز المساحات الحائرة التي يَشْغَلها على البياض ومرتهن بفَرَج قد لا يكون؟ أهو حقا زمن التراجعات الكبرى يُنيخ بكاهله على كل شيء، ويجرف بأدواته المعهودة ما تبقى من حُلمنا الجميل؟ أم أن المنابع ستظل فياضة مهما تعذّر المطر؟ بين عشق الحرية وعُنف المعنى، يتوزع جسمنا، الكتابة مجابهة، اندثار أسمى، فلنكتُبْ، لأن الكلمات من بَعدِنا أبقى!
– 13 –
هذا التفكيك الصريح ــ الحاصل الآن على امتداد التراب ــ لكل البؤر الضوئية، والقذف بأعراس الشعر الملتهبة إلى وهاد التكسب والمنافع لن يمنع حتما صوتها الجهير من مواصلة غنائه البهيج، هو الصوت – الكلام المؤجِّج لهدير الأجيال وعشقها، لن يَحُول ــ حتما ــ دون عبور عنفها البهي إلى ما وراء المتاريس والمنافع والمناصب والمراثي وكل تلك الحروب البلهاء، حيث القصائد اليانعة تُزهر في عيون الزمن مُزْنا، وحيث الشعر يُنجِز مصير الكائن والبلاد معا. ثمة قَطْعا، خلْف لسانها الآخر يوجد بعض من وجوهنا المُحتمَلة، بملامح أخرى، بعلامات راجفة تحفرها أيدي أطفال ينتسبون إلى سُلالة الغجر، قد ينهضون من هامشهم يوما ما؟ في غبش هذا الأفق يوجد ــ قَطْعا ــ أطفال آخرون يلغون المسافة بين حدود العشق الواحد، ويرسمون بين ثنايا القلب قمرا أو وجها فاتنا، محلوما به لهذا الفردوس المفقود. هو ذا بعض من مكامن عشقنا، لا نمُتْ! لنعانق فيضاننا، لنمارس حلمنا بعيون مفتوحة! لا نَسقُط ْ! ولنرَوِّضْ عشقنا، لننهض من رمادنا كل مرة مثلما فعل طائر العنقاء! لا نَرحل! ولنأخذْ أكُفّنا الممسوسة وبها نمسح خوفنا، لا نستعجلْ فينا الهروب!
– 14-
أسألُكَ، في نهاية هذه التحية – التّحويمة، أيها المفتون بلوعة الحَجَر والفاني في وِجْد الشعر عن حلم القصيدة الذي كان؟ عن حُجَّتها وحدود انتسابها للتراب ووجدانه؟ عن الاختيار الشعري الأجدى خارج قانون الحلبات وحروب النُّخَب؟ مِنْ أين يأتي السؤال الشعري الآن في بلد يُفجعه السؤال؟ هل يكفي أن تَحمِل القصيدة اليوم كلمات رنانة لتستحق صِفَةَ الشعر؟ وما معنى أن تَكتُب اليوم في المغرب شعرا عن غير المغرب؟ هذه أسئلة بشكوك أخرى، أُضيفها إلى هواجسكَ الجميلة خارج حدود الحداثة ومختبراتها، خارج تفصيلات النقد وحيرة الأشكال، لعلّ بعض الجواب يكمن في عمق الأسئلة نفسها؟ في قلب المحنة ذاتها، آو في رحم ذلك المرتقب الشعري الذي، بقدر ما تنضُج بداخله هوامش وقرابات ومسافات للأمل، تنضج أيضا داخِلَه الأعطاب؟ ربما يكون علينا أن نسكُبَ شوقنا بين الضلوع، حتى ينشي الحرف، من فرط تولهه، ونمدّدَ ليل الأعضاء لتذُوب حُرقتها، لنبحثْ فينا عن الشعر فقط، ولنتركْ أبوابَ القصيدة مُشرعة حتى تكون العودة ممكنة!
– 15 –
معذرة، سّي محمد، ما بِوُسعي من أجل مناسبة الاحتفاء باسمك العزيز، غير هذا الوله وقليل من الكلمات، أنثُرها على جبين القصائد، قُبُلات فائرة، وأعود إلى ناصية الحواس لأقرأ بعض الرجَفات، أغْسِلُ صدأ الروح بأنساغها، أُوقِدُ نار الشعر ببعض الأسماء القليلة والمضيئة وأعاقر الصفحات، أغازلها بأصابع مولوعة، وأحتمي بالحنين من الحنين. على هاوية الرؤيا، أُطِلُّ بين الرعشة والأخرى، بين السقطة والأخرى، أتفقد أعضائي، أشُدُّها إلى الدهشة، إلى ليل النص فقط، كي لا يبتلع الحِبر الجليل نشوتها، أصحو على هدير المسافات، وهسيسُ الحروف يطالب المفاصل بالرقص قي أحواض القول العليم، ألملمُ كلماتي، أُرجِّفها قليلا، أضاعفُ من تَوتُّرٍها، علّني أكون بذلك كتبتُ ــ فقط ــ رسالة إلى شاعر كلّمَهُ الحَجَر؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت هذه الشهادة في العدد (39) من مجلة “البيت” (يصدرها بيت الشعر في المغرب) وهو عدد خاص عن الشاعر محمد الأشعري، الفائز بجائزة “الأركانة” العالمية للشعر لدورة 2020.
بقلم: بوجمعة العـوفي