اِنْعقد بمدينة فاس مؤخرا، مؤتمر “جيل المستقبل” بحضور وفود من علماء التربية والنفس، وكتاب الطفل، ومهتمين وباحثين، من دول عربية، كالجزائر والسعودية، وجلهم ينتمون إلى جمعيات ومؤسسات مدنية، قاسمها المشترك هو مستقبل العالم العربي. وتناولت مداخلاتهم عدة مجالات، تصب جميعها في طرق وأساليب بناء الجيل الصاعد. وفيما يلي مداخلة الكاتب العربي بنجلون:
يجتاز العالم العربي منعطفا صعبا، لا ينجو منه إلا (السائقون الماهرون)! هذا المنعطف، يفرض التأني، والتفكير الجيد في المستقبل، والتخطيط المحكم، المستقبل الذي يُخْطئ من يظن أنه سيُبنى في خمسة أيام، أو شهر أو سنة، إنما في عقود؛ لأن هدم بيت متآكل (سهل) لكنَّ بناءَه من جديد، يفرض صبرا، ومُددا من ثلاثة إلى أربعة عقود، قياسا بدول سابقة، كاليابان والصين وسنغفورة، على سبيل المثال.. فماذا عسانا نفعل، ونحن أمام الأمر الواقع؟
دعونا نستحضر شموعا، فربما تضيء المنعطف جيدا لنمر منه بسلام. وهي ليست ضربا من الخيال، أو أضغاثَ أحلام، بل مُستقاةٌ من الواقع، ومن دول كانتْ إلى عهد قريب خاملةَ الذِّكْر، فأصبحتْ، بين عشية وضُحاها، نمورا قويةً، تهدد السِّباعَ والدَّناصير.
في ثَمانـينات القرن الماضي، زار مسؤولون صينيون أمريكا، وطرحوا في حوار سؤالا على وزير التعليم: كيف أصبحتم تتزعّمون العالم، وتتربّعون على عرش اقتصادياته
؟! فأتى جوابه على السَّجية، وهذا خطأ كبير، ستدفع عنه أمريكا ثمنا باهظا، لأن أسرار التقدم والتطور، تظل سرا خفيا على الدول المنافسة: فكّرنا طويلا، ووجدنا ألاّ سبيلَ لنا إلاّ (العنايةَ الفائقةَ بجيل المستقبل) فإذا أهْملناهُ، فقدنا رجلَ الغد، الذي يقود التنمية. لكنْ، كيف سنعتني به، أي ماذا سنقدم له، كي ننشئه ونبني شخصيته؟ وكانتِ الإجابةُ من علماء النفس والاجتماع، أنْ نهيئ للطفل تعليمين: تعليما نظاميا، وتعليما ذاتيا. فالنظامي يتلقاه في مدرسته، والذاتي أنشطة موازية، يمارسها في مراكز ومؤسسات الرياضة والفنون والمطالعة، لكنْ. وهنا توقف الوزير قليلا، لأن في (لكنْ) يكمُنُ السر، ثم قال: يجب أن تعطى للجيل الصاعد في مجالات الفنون والقراءة، جُرُعات من (الخيال العلمي) تنشط ذهنه، وتفتح عقله، وتحلق به في سماء الخيال، أي نبتعد مسافةً عن (الثقافة النقلية) ونلقي به في بحر (الثقافة العقلية).
وصدْقا قال، فالثقافة التي تسود، حاليا، الدول المتخلفة، هي الثقافة النقلية، أي (بضاعتنا رُدَّتْ إلينا). ثقافةُ الْمَضْغ والاجترار، وبالتالي، لا ننتج شيئا، عدا القيل والقال. وهي ما نلقنه لجيلنا، سواء في المدرسة والمنزل، ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وحتى الرقمية! ولمّا عاد الوفد الصيني، قرر أن يغير كلَّ المناهج والبرامج والوسائل التعليمية والتربوية. لكنْ، لا تظنوا أنه استغنى أو تخلى عن تراثه الأدبي، وهو البلد الأسيوي الغني، كالهند، بالأساطير والخرافات، والحكايات الخيالية، والأدب العجائبي. بل نفخ فيه من روحه، ليجعل منه (إكسيرَ الحياة) لجيله! وبالْمناسبة، لا ننسى أنّ الصين في حقبة الثمانينات، وأنا أذكر ذلك، كانتْ تترجم كتبا صينية إلى اللغة العربية، في مجال القصة، ومجال العلم، ومجال الرواية. وكانت تُصدر منها ملايين النسخ، وتوزعها على العالم العربي، أكثرَ مما تنتجه وتطبعه الدول العربية مجتمعةً. لكننا كنا ندير ظهرنا لها، بحجة أنها تنشر (إلحاداً)! وها هي الصين، الآن، تغزو القاراتِ بنتاجاتها الصناعية، وفي كل المجالات، التي تخطر ولا تخطر بالبال، وكل ذلك، نتيجة العناية بالجيل الصاعد.
إن التطور الذي شهدته أمريكا والصين ودول أوروبـية وأسيوية، لا يعود إلى التّغيير في المناهج والبرامج فقط، أو إلى العناية بالثقافة العقلية، وبالأنشطة الموازية، وسواها من الوسائل التربوية والتعليمية. إنّما إلى تغيير نظرتها إلى الجيل (عن قناعة تامة) وبالتالي، إلى المواطن، كعنصر فعّال في التنمية. وهنا أستحضر مثالين حيين: الأول، عكسته السينما العربية في شريط (آخر الرجال المحترمين) الذي مثّل بطولتَهُ نور الشريف في شخص (أستاذ) تاهتْ عنه طفلة في حديقة الحيوان، فاتصل بالوزير، ظانا أنه سيستنفر كلَّ أجهزته بحثا عنها. لكن مديرَ ديوانه، استغرب من طلبه قائلا: هل تريد أن تخبر الوزير عن طفلة ضلّتْ طريقَها؟ لماذا تعطي لقضية تافهة هذه القيمة؟ وأصبح هذا الأستاذ، في نظر الموظفين، مختلاًّ عقليًّا! والمثال الثاني من اليابان، فقد أرادتْ هيئةُ سكة الحديد أن تغلق إحدى المحطات النائية، بعد أن لاحظتْ أن المسافرين بها قلّوا، لكنهم عادوا عن قرارهم، عندما علموا أنّ طالبةً (قروية) ما زالتْ تتابع دراستَها، فعدّلوا مَواعِدَ القطار مع ذهابها وإيابها من المدرسة. كذلك، فإن ميزانية التعليم وثقافة الطفل في أمريكا، تحتل المرتبة الثانية، ولا تقبل المناقشة، لأنّ أيَّ تخفيض فيها، يعني (تفريطا) في (صناعة جيل المستقبل) الذي يُشكِّل عماداً قويًّا للبلاد! إذن، من هنا نبدأ، ومن الجيل الحاضر ننطلق، ولن تفيدنا الحلول الترقيعية، فهي وإن كانتْ ضروريةً، حاليا، لأنها تسد الثغرات، فإنّها، قطعا، لن تجتاز بنا المنعطف الصعب.
وإذا كان البعض، مِمَّنْ لا ينظرون بعيدا، يرى أن العناية بالجيل، عِبْءٌ ثقيلٌ، يُرهِق ثرواتِ البلاد، فإنه ينسى أن كل الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي نشهدها آنيا، سببها الأساسي، هو إهمالنا له. فما الذي يجعل العالم المتطور يهتم بجيله الحاضر، أكثر من أي مرحلة في حياة الإنسان؟ وكيف تتحقق التنمية الشاملة من تربيتنا وتعليمنا له؟
لقد اكتشف العلماء أن الإنسان، عند ولادته، يتوفر على مائة مليار خلية في مخه، وتكون هذه الخلايا حية ونشيطة في بدايتها، وهي المسؤولة عن كل العمليات الذهنية والنفسية والحسية، التي يمارسها الإنسان. ولكي تبقى حية، عليه أن يزاول، منذ طفولته الأولى، أنشطة متنوعة، كالقراءة والرياضة والفنون.. وإلا فإن هذه الخلايا، ستتلاشى شيئا فشيئا إلى أن تندثر، فيستحيل تنشيطُها من جديد. ومن ثَمَّة، يستحيل على الإنسان أن يندمج في مجتمعه، وأن يمتثل لقوانينه وأخلاقياته، وأن يسهم في تنميته وترقيته، لأنه أصبح مشلولا، لا يتوفر على خلايا فاعلة، وبالتالي، يصبح عالة على البشرية.
ولذلك، نلح على العناية بالجيل الحاضر، طيلة السنوات الستِّ الأولى (على الأقل) لأنه بعد ذلك، يتخذ طريقه بنفسه. فإذا تعود، خلال هذا الطور الأول، أن يعتمد على قدراته الجسمية والعقلية والسلوكية، سهل عليه أن يجتاز المراحلَ الباقية. فهذه المرحلة أهَمُّ في تشييد شخصية الإنسان، وما سيأتي بعدها، ليس إلا ترسيخا لما تلقنه وتعلمه أثناءها.
إذا كانت المرحلة الأولى، نسميها بـ(الواقعية) لأنّ الطفل فيها يفتح عينيه على أسرته، وبيته، وحيه، وروضته، وأصدقائه، وحيواناته الأليفة، وما يرتبط بهذه المجالات كلها، كي يتأقلم معها، ويندمج فيها. فإنه في المرحلة الثانية، من سِتّ إلى تسعِ سنواتٍ، ينتقل إلى (الخيال الحر) ليشحذ ذهنه، ويوسع عقله، بما يطالعه من قصص خيالية. وهنا، أتذكّر ما قاله ألبرت آينشتاين عن الذكاء، الذي يُوَلِّد الابتكار والاختراع، فيقول إن الذكاء هو الذكاء، عندي أو عندك، سواء كنت أروبيا أو أسيويا أو إفريقيا، لكنْ ينبغي أن يتنامى، منذ السنوات الأولى من حياتنا. نستنتج أن القراءة هي الوجبة اليومية، أي الطعام الذي يغذي خلايا المخ، ويُحَسِّن عملها. فينبغي ترسيخ (الثقافة العقلية) التي تحفز الجيل على الملاحظة والتساؤل والغربلة والنقد، وتنأى به عن الحفظ والتخزين. وليس هناك ما يحرك العقل، غيرَ الأدب، كالحكايات والقصص والأساطير والرحلات والأشعار. لأن من الخيال نستطيع أن نأتي بشيء جديد، وبدونه سنظل ندور في حلقة مفرغة، معتمدين على الآخر.
هناك من يريد، عبثا، أن يستعجل النمو، فيحرق المراحل، ضد الطبيعة. فالطفل في مراحله الأولى، يعيش طفولته، بلعبها وشغبها، باذلا طاقته الجسمية والنفسية، في اللعب والحركة والتعامل والتواصل والتفاعل مع الآخرين، وفي تلقي العلم والمعرفة.. لا أنْ نمهد له الطريق، باكرا، إلى التكنولوجية الحديثة، من ألعاب آلية، وشبكة رقمية، وأشرطة من الخيال العلمي، لأن كل تلك الوسائل، تبسُط بين يديه (وجباتٍ) ناضجةً من الأفكار، دون أن يُشَغِّلَ فيها عقله، أي تسرق منه الفكر والخيال، وتُبْطِل لديه الرغبةَ في الاكتشاف والابتكار، فضلا عن الأمراض النفسية والصحية والاجتماعية.
صناعة جيل المستقبل
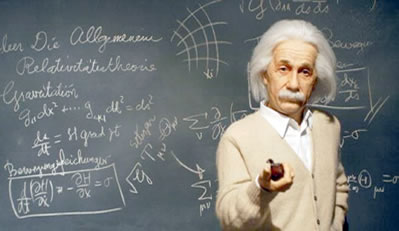
الوسوم


