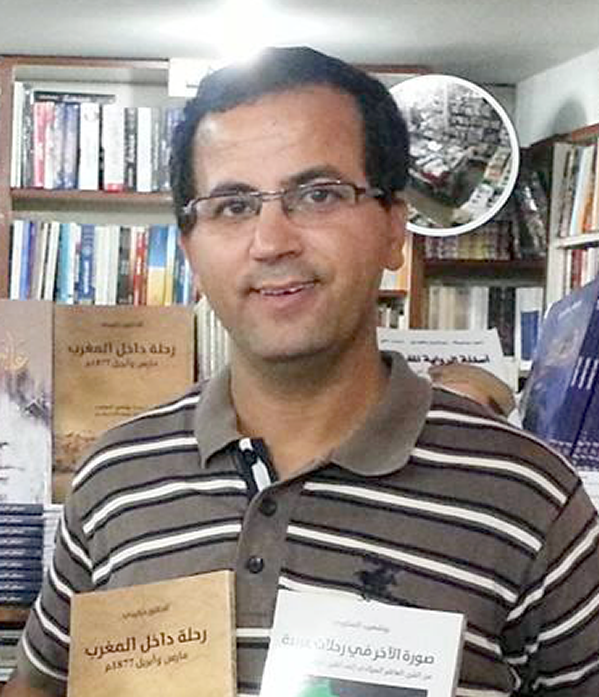> بقلم: بوشعيب الساوري
على الرغم من كون الكتابة تتوق دائما إلى خلْق مسار حر عبر التواريخ والثقافات والأزمنة والأمكنة، وإن كان النص الأدبي لا مدينة له؛ فإن ظهور الفن الروائي ارتبط بالمدينة، وأن هناك نصوصاً تظل مرتبطة بمدن معينة، لأن فكرتها وأحداثها ومتخيّلها وشخوصها وفضاءاتها متماهية مع تلك المدن، فتصبح علامة دالة عليها. وبما أن هناك أدباً موجودً فإن هناك مدناً حاضرة في ذلك الأدب. لكن كيف تحضر تلك المدن في ذلك الأدب؟ لا شك أنها لا تحضر بصورة واحدة، ومن ثمّة، تصير المدينة الواحدة مدناً متعددة، انطلاقاً من عملية الخلق والتخيّل التي يطلع بها كل كاتب وأيضا التجارب الإنسانية التي يشخص من خلالها أفكاره، وتبعا لعلاقته بها؛ وهو ما جعل أسماء بعض الكتَّاب ترتبط ببعض المدن وليس غيرها؛ كبودلير وباريس، وجويس ودابلن، ونجيب محفوظ والقاهرة، وكافكا وبراغ، وبول باولز وطنجة، وإدوار الخراط والإسكندرية، وعبد الله العروي وأزمور والحبيب الدايم ربي وسيدي بنور.. وإذا كانت الرواية بنت المدينة، فإنها لم تحصر اهتمامها بنمط الحياة داخل المدينة، وإنما امتد اهتمامها لينفتح على الأقاليم والمدن الصغيرة والأرياف. وتبقى المدينة في الأدب نتيجة لآثارها، بالنظر إليها كمكان، على روح الكاتب، إيجاباً أو سلباً، حُبّا أو كراهية، حرية أو إكراهاً، متعة أو معاناة، إقامة أو عبوراً؛ لأنها جزء من ذاكرته وامتداده الثقافي، ومكون من مكونات معينه التخييلي، وتبعاً لاختلاف هذه العلاقات، تختلف مدن الكتاب وتختلف نظرتهم لها وشهادتهم عنها. والكاتب حسن الرموثي واحد من أبناء مدينة الصويرة (موكادور) الخُلص بل من ولي من أوليائها الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الذين يتفانون في حبها وخدمتها ويواجهون تحولاتها ويسعون جاهدين، بما أمكنهم حفظ ذاكرتها من المحو والنسيان في سياق يعرف تحولات صار يعدم فيها الإنسان قيم الاعتزاز بالانتماء الحضاري. وقد حضرت مدينة الصويرة في جل أعماله الإبداعية. ويبقى كتابه السردي الأخير مدائن الحب والتيه1 هو الكتاب الذي جعل منها بطلة لمحكيه السردي الذي يقدم لنا فيه حسن الرموثي شهادته على حاضر مدينته وما يشهده من تيه وزوال ملامحها الإنسانية من خلال تحولاتها العمرانية والسكانية والثقافية وأثرها على كل كائنات المدينة انسها وطيورها، بل يغدو الكتاب أحياناً مرثية لمدينة في حالة احتضار أو موت بالتقسيط، بعد أن توقف كل شيء جميل فيها تاركاً مكانه مُكرَهاً لما هو أقبح، مدينة صارت غائبة في حاضر الكاتب وتظل حاضرة في ذاكرته وذاكرة مجايليه. كما أنه نقد حاد لكل التحولات السلبية التي طالتها حتى جعلتها تتنكر لأبنائها: “مدينة تبتعد عنّا الآن، تُغادرنا، أو نغادرها، لا فرق، الأمر سيان، حين تسرق أحلامنا، لم تعد لنا، تنكّرت لأسمائنا.”(ص.15.) بل يرى كما لو أن مدينة ذهبت وحلّت محلّها أخرى، ودليله على ذلك هو ما شهدته من تحولات وكأنها تعرّضت لعملية مسْخ طال معمارها وكائناتها وطبيعتها وبيوتها وجدرانها. يقول: “فتتحول المنازل القديمة والتاريخية إلى فنادق، أما المنازل البسيطة فتأكل الرطوبة جدرانها، ويعلو الصدأ شبابيكها، كل شيء تغيّر، الأشجار، البحر، البشر حتى النوارس.”(ص.7.) تحولات يعتبرها الكاتب أعطاباً وانكسارات يصعب جبرها، خصوصاً بعد أن استباحها الغرباء أو الغزاة أو البرابرة، كما يسميهم الكاتب، وتنكرت لأبنائها ورمتهم إلى الهامش ودفعتهم إلى الحلم بالسفر إلى ما وراء البحار. ومقاومة منه لسطوة التحولات المُتسارعة للمدينة يستحضر حسن الرموثي ماضيها البهي المحفوظ في ذاكرته والممتد إلى طفولته، عبر استعادة مجموعة من ذكرياته عنها وما كان يقوم به من أشياء جميلة، بنوع من الحنين، ويحاول تذكيرها بماضيها الذي تنكرت له في زمن الغزاة. يقول: “قبْل سنوات كنا نركض نحو البحر، نغسل براءتنا في موجه…”(ص.10.) مقابل حاضر يسوده التيه والحيرة اللذان يطولان سكان المدينة بعد أن استباحها الغزاة وما ترتب عن ذلك من تحولات سلبية لطخت وجه المدينة، واتخاذها ملامح مغايرة لا تليق بها جعلتها هاربة عن ماضيها. فيترتب عن ذلك حضور مجموعة من التقابلات بين ماضيها وحاضرها، إذ أن كل القيم النبيلة انتهت في الماضي وحلّت مكانها أخرى نقيضة لها: “آه ما أشد حظ هذه المدينة بالأمس! وما أتعسها اليوم!”(ص.14.). مشخصاً المفارقة والتوتر الذي يعتمل في دواخله بين مدينة كانت وأخرى أصبحت. يقول الكاتب بحسن نقدي: “وأشجار كثيرة اقتلعت، لم يعد لها أي أثر، مساحات خضراء تحوّلت إلى فضاءات مبلّطة بالزليج الباهت، جرداء لمهرجانات الزيف والرقص الرخيص، فضاءات لجيل لا يُحسن سوى تحريك الأرداف، وحتى العصافير التي تعودت عليها رحلت.”(ص.38.). ليؤكد أن المدينة فقدت كثيراً من خصائصها المائزة كالهدوء والبراءة والأصالة والصمت وتم استبدالها بأخرى سلبية كالبهرجة والضجيج وتنكّرت لأبنائها وجعلتهم يكتوون بالاغتراب: “تحس بالاغتراب كأنك خارج من رحم التوابيت، أو أن أرضاً يباب لفظتك، لا تدري من أين أتيت؟”( ص.52.) فيعيش الكاتب محنة كبرى حينما إذ يجد نفسه في صراع مع التحولات الكارثية للمدينة فيحاول مقاومتها، بحس المثقف العضوي المنخرط في هموم مدينته وشؤونها التي يراها قد اغتيلت، بالاستعانة بالقراءة لكتاب عالميين كبار. يقول: “الكتاب هو ملاذك الأخير لتنفض عن نفسك قبح هذه المدينة، أن تجد لها صورة أخرى في قراءاتك.”(ص.21.) وأيضاً عبر استعادة ذكرياته عن المدينة من أجل الوقوف صامدا ضد قبحها: “قاوم، حاول أن تستعيد ذكرياتك، وأنت مغمض العينين، أن تشعل في دواخلك كتلاً من المشاعر الملتهبة، أن تزيل هذا القبح، هذه المساحيق الرخيصة المستخلصة من بؤسنا…”(ص.22.). خصوصاً وأنه بدأ يشعر بأنه صار غريبا في مدينته التي أخذت تضيق به أمام غزو البرابرة الجدد، كما بدأ يشعر بهزيمة ثقيلة ولا يريد استساغتها فيعيش عتمة خانقة، ومع ذلك يظل متشبثاً ببصيص من أمل يشرق يزيح عنه وعن مدينته عتمتها، بعد أن استبيحت المدينة للغزاة لم يتبق للكاتب سوى الحلم الذي يرى فيه مدينته بصورة أروع وقد اغتسلت من قُبح الغزاة وتصالحت مع ماضيها: “لأمنحك أيها الغروب غروباً جديدا يليق بزرقة البحر، وأمنحك أيتها المدينة وجها طفولياً وضفائر بلون قوس قزح.”( ص.58.) ويعيد للبسطاء ما سلبته منهم تحولات المدينة…ويعيد لكئنات المدينة، بشكل عام، ما سلب منهم، طارحاً أسئلة حبلى بالأمل في ولادة جديدة للمدينة، رغم أنه يتوجس
خفية على مستقبلها الضبابي الذي يحاول إنقاذه ولو بالحلم والوهم وعلى الرغم من أن تيهه يشوش على أحلامه وعلى مستقبله وتطلعاته ويتسلل اليأس إليه. ومع ذلك يظل حلمه قائماً بل يأمل في تأجيل موته عله يستطيع إعادة الحياة لمدينته. متمسكا بأمل جديد للمدينة: “متى تشرق على هذه المدينة شمس جديدة، لتطهر هذه الابتسامات، وتبعث الدفء في العروق.”(ص.22.) متمنياً عودة المدينة الهاربة في ذاكرته: “تتمنى أن تصحو ذات يوم، فتجد هذه المدينة قد عادت ثلاثين سنة إلى الوراء، لتعيد ترتيب حلمها..”( ص.23). وفي أحيان كثيرة ينتابه اليأس ويشوش على مستقبله ويتسلل إليه التيه، كما يتسرب إليه النسيان أمام سطوة الواقع وتحولاته الكارثية وقسوته فيشوش على ذاكرته، ويعتقد أن حبه لمدينته مجرد وهم وتصبح ذاكرته بمثابة أوهام، ويعتبر أن حنينه بلا جدوى فيدعو إلى الجنون كحل للهروب من سطوة التحولات الكارثية مستعيداً في ذلك سير بعض مجانين المدينة (حسن الهبيل، بوتوميت، قرن 14، بلاك، الكبيش). وعلى الرغم من ذلك يظل وفياً لمدينته: “سنظل نمنحك الوفاء أيتها المدينة، أيها الحلم…” (ص.104). هكذا يجسد هذا النص السردي لحسن الرموثي تلك الوضعية المتوترة التي يعيشها الكاتب بين الماضي المضيء لمدينته الصويرة وحاضرها القاسي وتطلعه الحالم إلى استعادة المدينة لبريقها وتصالحها مع ماضيها ومع أبنائها، بلغة دافئة بمشاعر تراوحت بين الخوف والغربة والأمل والرجاء واليأس يحضنها حب صادق ووفاء يكنهما الكاتب لمدينته.
هامش:
حسن الرموثي، مدائن الحب والتيه (نص سردي)، مطبعة وراقة بلال، فاس، الطبعة الأولى، 2015