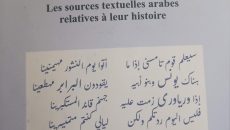كان الأسبوعان الأخيران من شهر مارس 2020 بمثابة أيام قيامية ( Journées apocalyptiques ) لم يعشها العالم من قبل أبدا. فبعد ظهور فيروس كورونا في البداية كوباء، سرعان ما تحول الحديث عنه كجائحة كبرى، ضربت الكرة الأرضية بكل بقاعها وقاراتها وبلدانها وجل مناطقها، عدا بلدان قليلة أو منغلقة أصلا ككوريا الشمالية وكوبا والشحيحتين إعلاميا. وبدأت الآلات الإعلامية الكبرى والقنوات التلفزية في العالم أجمع، في الحديث عن الجائحة في نشرات الأخبار بل خصصت حيزا زمنيا شاسعا لندوات ولقاءات مفيدة جدا من أجل التحسيس والتوعية الصحية والإجرائية لمنع الإصابة بالعدوى، والتصدي لها وفي كل المجتمعات. كثيرة هي الأسئلة التي تناسلت كالفطر، حول هذا الفيروس الدخيل، وحول طبيعته وخاصياته وكيفية انتشاره وانتقاله بين البشر بسرعات كبيرة، ووتائر عالية جدا عبر الاختلاط الإرادي واللاإرادي، مع التركير على كيفية أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه. وفهم العالم أن انتشاره السريع تم بواسطة الإنسان وتنقله بين المطارات والعواصم والمدن، بواسطة التنقل بالطائرة أساسًا وأيضا بواسطة وسائل النقل الأخرى. نتذكر مثلا أن إجراء مباراة في كرة القدم بين فريقي فالانسيا الأسباني وأطلنطا برغامو الإيطالي برسم ثمن نهاية البطولة الأوروبية المجرى يوم 19 فبراير 2020، كانت بمثابة إطلاق حكم اللقاء صافرة انطلاق وتحرير الفيروس مع انطلاقة المباراة، من رئة مصاب أو رئات بعض المصابين القلائل جدا، عبر الصراخ وترديد الشعارات ونثر الرداد، ثم انتشاره في الهواء بكل أرجاء ومدرجات ملعب «غيسيبي ميازا» بمدينة ميلانو كلها. ويعتبر هذا اليوم بمثابة اليوم الصفر أو المبارة الصفر أو القنبلة البيولوجية التي أدت إلى تسارع انتشار الفيروس وبإيقاعات غير مسبوقة في التاريخ، بكل من إيطاليا واسبانيا المتضررتين أكثر من جائحة كورونا في أوروبا وبدون منازع (حسب عدد وفيات الفيروس بهذين البلدين يوميا). تم إغلاق جل مطارات العالم وكذا الحدود بين جل بلدان المعمور. تبين أيضا أن الصين التي انطلق منها أول مرة هذا الفيروس اللعين، أو ما سمي بفيروس كورونا، ثم أعطي له اسم كوفيد 19، هي بلد منفتح على القارات الخمس، نظرا لمكانتها الاقتصادية الكبرى، بل أخذت عن جدارة وتخطيط وتبصر اسم ورشة أو مصنع العالم (Atelier ou usine du monde). وتعتبر اليوم بلدا مصنعا ومنتجا لكل أنواع المنتوجات الصناعية والتكنولوجية والسلعية، وقطبا جاذبا لكل أشكال «البزنيس» والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، دون إغفال ولوجها في العشرين سنة الأخيرة إلى ممارسة البحث العلمي والترويج المعرفي لكفاءة جامعاتها وعلى رأسها جامعة شانغهاي. تحتل الصين إذن موقعا اقتصاديا وسياسيا كبيرا في عالم اليوم، والمتلاطمة أمواجه بسبب الصراع على الهيمنة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة. لماذا الحديث عن الصين؟ بكل بساطة لمسألتين أساسيتين، الأولى شهادة ميلاد فيروس كورونا على أرضها، وتتعلق الثانية بصناعة الكمامات. وهي اليوم تحتكر إنتاجها منذ عقدين تقريبا وبشكل شبه تام. وأيضا الدور شبه الأحادي لتزويد العالم أجمع بها خلال أزمة الجائحة. لن أتحدث عن فيروس كورونا بالتفاصيل وكل ما صاحبه من إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة الصينية، بل فقط الإشارة إلى ظهوره في مدينة يوهان مند نهاية شهر دجنبر 2019. وهناك من الصحفيين وحتى العلماء من أشاروا إلى كون ظهوره كان سابقا عن هذا التاريخ أي منذ شهر نونبر 2019، وتم التستر عليه من طرف الحكومة الصينية؛ بل إنها أخفت الكثير من الحقائق و الأسرار والإحصاءات حول الفيروس عن العالم. وربما يكون هذا نكاية في تفوق الصين في السيطرة عليه وبوسائلها التنظيمية والانضباطية والتحكمية، مع إلصاق تهمة المسؤولية عن ظهوره ثم انتشاره.
وهكذا لم تسلم الصين من حملة شعواء تزعمها الرئيس الأمريكي بكونها من قام بنشر الفيروس بشكل متعمد. ثم برزت نظرية المؤامرة، وتفنن الصحفيون وبعض كتاب مقالات الرأي، ثم بعض الصحف العالمية في نشرها وترويجها كما لو كانت حقيقة ثابتة. بل حتى بعض كبار «العلماء» مع الأسف انساقوا لها ومنهم مكتشف فيروس السيدا أو «الأيدز» البروفيسور لوك مانطانيي (Luc Montagnier) ورغم هذه المزاعم فنظرية المؤامرة لم تصمد كثيرا.
رجوعا إلى مسألة الكمامة (كلمة كمامة تنطق بكسر الكاف) وهي موضوع حديثنا في هذا المقال وعما عشناه في زمن كورونا، يمكن القول إنها تعتبر نجمة الحجر الصحي بدون منازع. وسرعان ما أصبحت أيقونة جائحة كورونا وماركتها المسجلة بامتياز. فالجميع يستعملها ويغلق بها فمه وأنفه، أي سد القنوات والمسالك الأولى لاستقبال العدو الكوروني، لذلك ألزم الجميع قانونيا بوضعها، وفي جل بلدان العالم، حماية لصحته وحياته ولمنع العدو الفيروسي الخطير من الولوج والتسلل إلى الرئتين والاستقرار بهما لا قدر الله. آنذاك وجب توديع العائلة والأحباب والأصدقاء والذهاب إلى المستشفى وكل شيء بيد الله. وقد هيأت السلطات المغربية بالمناسبة ظروفا جيدة وشروطا متقنة لاستقبال المصابين في جل مستشفيات البلاد وتجنيد جل مصالحها الصحية. أصبحت الكمامة إذن هي رمز الجائحة الاستثنائي، أو ذلك «الاموتيكون» الجديد والأشهر حسب لغة الفسابكة (الكلمة التي نحتها الصحفي الصديق عبد الرحيم التوراني)، ويمكن بدون تصنع أن نصف بها عصر كورونا ونسميه «عصر كورونا الكمامي» عندما ستنسج الحكايات حول الظاهرة ويتم رويها وسردها للأجيال المقبلة في القادم من السنين. إنها الحاجز الأول أو الحائط الذي يقف سدا منيعا أمام الرذاذ المتطاير من فاه المحاور المقابل أو الشخص الذي نقف بجانبه في الطابور إذا عطس أو أخذته نوبة سعال حادة. في السابق، لم نكن نعير كثير اهتمام بوضع أو وجود الكمامة لدى الأطباء والممرضات والممرضين في كل الفضاءات الصحية والاستشفائية، وكذا لدى بعض العمال في المعامل المنتجة للمواد الكيماوية والسامة والخطيرة، أو في تدخلات رجال المطافئ. كانت الصورة عادية ولا تقلقنا أبدا مادامت مرتبطة بعمل هذه الأطر. أما وأن تصبح لباسا أو ملحقا أو لنقل «اكسيسوارا» إجباريًا كسائر الملابس العادية التي نرتديها قبل مغادرتنا البيت، فهذه حكاية لم يستسغها الكثيرون بسهولة، لأن ذهنيتنا وثقافتنا وربما تاريخنا لا يرتبط بها، باستخدامها من طرف العموم، وربما كانت لكل واحد منا خلفياته وقناعاته في ارتدائها من عدمه. بالطبع لسنا كبلدان آسيا وخصوصا اليابان وكوريا والصين وكلها بلدان يستخدم سكانها الكمامة منذ زمن بعيد. في اليابان وكوريا الجنوبية المحصنتين أكثر، يعتبر استخدام الكمامة من طرف الجميع نوعا من الطقوس المألوفة والبسيطة بل والضرورية في الفضاء العام وحتى بالنسبة للأطفال، وتدخل ضمن ما يكتسبه الإنسان من مبادئ التربية والتعليم التي يتلقاها في المدرسة، من خلال دروس الوقاية المدنية، نظرا لنسب التلوث المرتفعة التي يعرفها هذان البلدان الصناعيان الكبيران. كما تستعمل في اليابان اتقاء لأخطار التلوث النووي المحدقة به، كما وقع في كارثة فوكوشيما في شهر مارس 2011، أو خطر الزلازل. كما تنطبق المسألة على الصين اليوم. والملاحظ هو احترام شعوب هذه البلدان لمجموعة من القيم المتداولة والتي أصبحت راسخة كسلوكات وقائية صحية وحضارية يلتزم بها الإنسان الياباني أو الكوري الجنوبي وبدرجة أقل الصيني، كاحترام قوانين السير أو النظافة أو الوقاية أو احترام الأشخاص المسنين والاعتناء بالحدائق والأشجار والزهور، حتى تخال أنهم رفعوها إلى درجة التقديس وبصرامة مبدئية. بل هناك نوع من الزهد في التعامل معها والاعتناء بها، مع الاحتراز والحذر الذي تبديه سلطات هذه البلدان. لذلك فاستعمال الكمامة يعتبر مسألة عادية لدى الجميع. وهذا ما يفسر أنها خرجت بأقل الأضرار من الجائحة مع تدبيرها الجيد والصارم للجائحة ككل، مقارنة مع بلدان متقدمة أخرى كإيطاليا واسبانيا وفرنسا بل أسوء كحالة أمريكا. وهذه البلدان الثلاثة أي اليابان وكوريا الجنوبية والصين لم تعرف ما سيسمى بأزمة الكمامات كما عاشتها أوروبا وأمريكا وكثير من الدول، لكون آلتها الإنتاجية وصناعاتها تنتجها باستمرار، وما نعرفه عن اليابان أنها بلد مجتهد وعملي وينطبق عليه المثل المغربي القائل: «الدق والسكات»، أي العمل والاجتهاد في صمت وبدون ضجيج. أما أوروبا فقد وجدت نفسها أمام أزمة حادة في نقص الكمامات وهي في أمس الحاجة إليها. لأن بعض هذه البلدان كفرنسا وايطاليا واسبانيا كانت كلها قد فوتت معامل إنتاجها إلى الصين في إطار ما يسمى بعملية النقل أو التوطين بالخارج (Délocalisation) أي ببلدان تكون فيها كلفة الإنتاج ضعيفة والأرباح عالية وأجور العمال هزيلة. استغلت الصين طبعًا عملية تسويق الكمامات نحو أوروبا، زودت إيطاليا بـ 10 ملايين منها، ثم كذلك فرنسا واسبانيا وأمريكا وبعض دول إفريقيا. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ما عشناه من ظواهر لم تكن يوما تخطر على بال في ما يخص التضامن بين الدول، كامتناع ألمانيا عن مساعدة إيطاليا وإغاثتها، قرصنة بحرية وتحويل اتجاه باخرة مزودة بأجهزة التنفس إلى إيطاليا بواسطة حرسها البحري، وكانت متوجهة إلى مستشفيات تونس، إفراغ طائرة محملة بالكمامات بمطار براغ التشيكي عند توقفها به، وتوزيع حمولة صناديق الكمامة على مستشفياتها، وكانت أهدتها الصين لإيطاليا. وهذا ما يمكن تسميته بـ «قرصنة حضارية منظمة» أو «لصوصية ناعمة» من طرف الدول هذه المرة، وفي عصر الصورة والانترنيت وحقوق الإنسان، وبدون مروءة ولا حياء. يا للعجب كيف يدفع الخوف والهلع والأنانية دولا ذات سيادة للقيام بمثل هذه الأفعال.
لا ننسي كذلك أن استخدام الكمامة أثار لغطا لغويا وكلاميا أو «بولييميكا» بيزنطيًا صاخبا وعنيفا حول جدوى وضعها من عدمه، لمقاومة الفيروس ببعض الدول الأوروبية وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية، ونخص منها فرنسا القريبة منا على سبيل المثال لا الحصر. وهذا «البوليميك» لم يسلم منه بروتوكول العلاج المعتمد على الكلوروكين والازيطروميسين، والذي كون وجبة دسمة وفي كل المنابر الإعلامية في العالم أجمع، لما سمي بصراع المصالح (Conflits d’intérêts) وربما نتناول موضوع هذا البروتوكول العلاجي في مقال لاحق، وقد استعمل بنجاح في كثير من الدول والبلدان الأفريقية ومنها المغرب.
في فرنسا إذن، ونظرا لندرة الكمامات وعدم إمكانية تلبية طلبات وحاجيات الفرنسيين منها، وحتى تلبية طلبات القطاع الصحي عند بداية الحجر، نشأت صراعات بين أطراف متعددة حكومية وبرلمانية وطبية وصحفية، ومن خلال أشكال عنف رمزي لغوي أدى إلى توترات وتشنجات فارغة، منها من يحاول تبرير الخصاص بنفاذ المخزونات أو عدم وجود نظرة استراتيجية لتزويدها والحفاظ عليها، أو في أخطاء تفويت إنتاجها إلى الصين. وكانت أطروحة التنقيص من أهميتها الوقائية والصحية أكثر الأطروحات التي تم الترافع حولها باستماتة في بعض الأحيان، استعملت فيها كل أسلحة التمويه والحذلقة اللغوية والكلامية الجوفاء، تقول الشيء ونقيضه وبالتالي كانت فاقدة لكل معنى. وهذه لعمري قمة العبث وقمة الاستهزاء بالعلم والطب والوقاية، ويا حسرة هذه المرة من طرف صحفيين مرموقين ومنهم ألان دوهاميل (Alain Duhamel) الصحفي المشهور، أو حتى من طرف أطباء متخصصين وهذه مهزلة بكل المقاييس. كان السبب طبعا هو الدفاع عن فشل الدولة الفرنسية في توفيرها الكمامات للمستشفيات أولًا وللفرنسيين أجمعين ثانيا. وربما حماية الرئاسة الفرنسية من الحرج الذي سببته لها هذه القضية. في الأسبوع الثاني من شهر يونيو الحالي تم تعيين أربع لجان للبحث في كل جوانب تدبير جائحة كورونا بشكل عام في فرنسا، من الرئاسة إلى الحكومة وجل الأطراف التي كان لها دور أو أدوار خلال هذه المرحلة، وهي لجنة البرلمان ولجنة مجلس الشيوخ ثم لجنة الحكومة و أخيرا لجنة الرئاسة.
وفي انتظار ما ستسفر عنها نتائج وخلاصات هذه اللجان، أترك الحديث عن مسألة الكمامة كما عشناها وعاشها جميع المغاربة ببلادنا إلى الحلقة المقبلة.
بقلم: محمد بلحسن