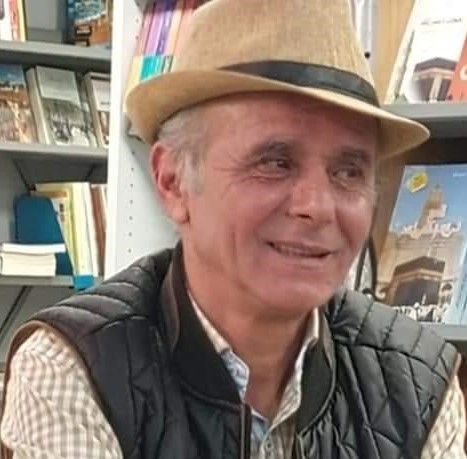لقد بقيت وسائل الإعلام التقليدية لفترة ليست بالقليلة مسيطرة على المشهد الاتصالي في المجتمعات البشرية، كانت النظرة التقليدية تعتبر وسائل الإعلام بأنها وحدة مركزية للتواصل لا يمكن تجاوزها كأدوات للضبط والتحكم السياسي والاجتماعي في المجتمعات الراهنة، إلا أن التطورات التكنولوجية الحديثة أحدثت نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصال، جعلته ينفلت من بوتقة الرقيب لينفتح على فضاء واسع فيه التنوع والتعدد الثقافي واللغوي والفكري والإيديولوجي، فضاء تغلب عليه الديناميكية وحرية التعبير عن الهويات الفردية والجماعية من خلال المحتوى والتوزيع والتلقي والاستجابة.
تعتبر المرحلة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي انقلاباً على نموذج الاتصال التقليدي، باعتبارها عملية انسلاخ جذرية تتجه نحو التحرر، والتأسيس لرؤية جديدة قوامها البناء التواصلي الديمقراطي والقطع مع الاتصال ذي البعد الخطي. إنها عملية إنهاء أشواط الشمولية والرؤية الأحادية، عملية إعادة إنتاج تواصل يراعي الضرورة التفاعلية، والمشترك الجماعي في بعده الانتشاري الزمني والمكاني.
1) الوسائط الجماهيرية les media des masses
لم يخلق الإعلام الجديد مجالًا افتراضيًّا جديدًا، كما يذهب إلى ذلك البعض، بقدر ما عمد إلى شد عَضد المجال العام القائم، لكن من خلال تنويع أدوات الضغط والتدافع؛ لذلك فإن “المجال الافتراضي ليس فضاء موازيا للمجال العام الذي تحدث عنه “هابرماس”، بقدر ما هو امتداد له وتوسيع لفضاء فعله وتفاعله، إنه إغناء لأدواته ووسائله ومكوناته، وليس بناء جديدا على أنقاضه، أو بمحاذاته” على حد تعبير يحيى اليحياوي ضمن مقاله “الشبكات الاجتماعية والمجال العام بالمغرب: مظاهر التحكم والدمقرطة”، فالمعرفة بالنسبة له، “باتت بزمن مجتمع الإعلام ملكا مشتركا تحطمت على محاربه شتى أشكال اللاتوازن والإقصاء اللذين كانا سائدين بزمن الندرة، زمن ما قبل الثورة الرقمية.”
في ظل الثورة الرقمية المعاصرة، انتشرت الوسائط الجماهيرية الجديدة نظرا لدورها في عملية التواصل حيث ساهمت في ظهور “طبقة البرونيتاريا” وتعزيز دورها لمنافسة “رأسماليي المعلومات” رغم توفرهم على خبرات تقنية عالية ومعدات تكنولوجية متطورة، وهذا ما أوضحه “جول دو روزناي” ضمن كتابه “ثورة البرونيتاريا: من جماهرية الوسائط إلى الوسائط الجماهيرية”
Joël DE ROZNAY, La révolte du pronétariat:des mass média aux média des masses.
ساهمت التطورات المتلاحقة لشبكة الإنترنت في إيجاد شكل جديد من الإعلام، الذي يشمل الشبكات الاجتماعية الافتراضية، والمدونات، والمنتديات الإلكترونية والمجموعات البريدية، وغيرها من الأشكال والأنواع المتعددة. مع ظهور الإعلام الجديد تغيرت علاقة الأفراد مع الإعلام، حيث أصبحت تفاعلية قائمة على إنتاج الفرد للمضامين الإعلامية والتعليق عليها ونشرها بشتى الوسائل. انتقل الفرد من تلقي المضامين المحدودة إلى استخدام المضامين المتنوعة، وهكذا أصبح للمستخدِم خيار التفاعل مع المضامين الإعلامية.
2) الدعاء في الوسائط الجماهيرية
في ظل الثورة الرقمية، أصبحنا اليوم أمام ظاهرة جديدة في بلادنا تتمثل على الخصوص في نشر الأدعية وبشكل مكثف عبر الوسائط الجماهيرية les media des masses، أدعية نجهل أصلها ومصدرها ومقاصدها، توزع كل صباح وليلة جمعة أو يوم جمعة أو بداية شهر هجري جديد وكذا الأعياد الدينية، حتى أصبحت تشكل عبئاً على الكثيرين مما يدفعهم لتجاهلها والعمل على حذفها من هواتفهم المحمولة دون حتى الاطلاع عليها.
هذه الأدعية تبدو في بعض الحالات مبتذلة، تكرس مضامينها أحيانا التواكلية أو طلب المستحيل من الرعاية الإلهية، على الرغم من أنه كانت ومازالت لنا أدعية، ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، أدعية إيجابية عفوية وفورية فطرية صادقة، كلها حِكم مليئة بالمحبة والتفاؤل والطمأنة، تبعث الأمل وتزرع الأخلاق الحميدة الخالصة والقيم النبيلة في النفوس البشرية ولها وظائف تربوية.
إن صياغة هذه الأدعية المنتشرة وبشكل واسع والمتدفقة دون توفق عبر الوسائط الجماهيرية، والتي نجهل صانعها، تكون في أبعض الأحيان مليئة بالأخطاء النحوية أو ليست لها أي قيمة دلالية، مما يوحي أن أصحابها ذوو مستوى تعليمي وفكري متدن، أو آخرون قد تكون نواياهم السخرية واستصغار المتلقي، وهذا ما يدعونا إلى الحيطة والحذر عبر القراءة المتمعنة والتدقيق اللغوي والوقوف على مضامينها ومحتوياتها.
اعتبر محمد مغوتي ضمن مقاله “في أدعية الكراهية” أن الدعاء عند المسلم يكاد يكون سلوكاً ملازما لكل تصرفاته وأفعاله. فهو يدعو لنفسه وللمقربين منه، ولغيرهم من أبناء جلدته، بكل عفوية، وفي كل مناسبة وحين، حيث ترتفع أكف الضراعة إلى الله في المساجد والمجالس والولائم والمآتم. أن يناجي المسلم ربه، ويطلب عونه ورحمته في الدنيا والآخرة، فذلك تعبير عن خضوعه وعبوديته له. وذلك طبعاً أمر مرغوب فيه، وواجب من الناحية الدينية، لكن، عندما ينتقل الدعاء، من مستواه التعبدي الذي يجمع بين العبد وربه، ويتجاوز طلب الخلاص الفردي إلى الخلاص الجماعي، ويتحول إلى نشيد للحقد والبغض، فإنه يصبح خطراً، في حد ذاته، لأنه لن ينتج إلا العنف والكراهية والموت.
خلافا لمضمون الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(، انتشرت كذلك وعبر الوسائط الجماهيرية، أدعية الكراهية بين الشعوب، منها على سبيل المثال لا الحصر: “اللهم شتت شملهم”. “اللهم رمل نساءهم ويتم أبناءهم ونكس راياتهم”. “اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم”. “اللهم جمد الدم في عروقهم”.
على الرغم من ذلك، يمكننا القول إن الإرادة الإلهية زرعت النظام في الكون وفق قوانين ثابتة أزلية لا تتغير وهذا واضح من مضمون الآية الكريمة “وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا”، أي أن القوانين الإلهية لا تتبدل بتبدل الظروف وأهواء الناس أو بسبب واقعة أو من أجل مخلوقٍ مُعيّن، إلا أننا نجد اليوم أنفسنا أمام بعض الأدعية تطلب من الرعاية الإلهية التدخل لتحقيق غاية أو هدف بخرق قوانينه الأبدية غير القابلة للتبديل، وندرج على سبيل المثال لا الحصر: إنقاذ الطفل ريان رحمه الله من الموت والذي استمات رجال الإنقاذ لانتشاله من بئر ضيقة، والذي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، أو طلب المستحيل من العون الإلهي كشفاء مرضى جميع المسلمين في ليلة واحدة أو في يوم واحد.
3) الجهل المقدس من منظور محمد أركون
هذا يعود بنا إلى الراحل محمد أركون الذي أكد من خلال استضافته في برنامج «مباشرة معكم» للقناة الثانية على أن هناك نوعين من الجهل، النوع الأول هو الذي سماه بـ “الجهل المقدس” كما جاء في كتاب المفكر الفرنسي “أوليفي أوا”، أن المجتمع هو الذي أدى بالفاعلين الاجتماعيين إلى تقديس الجهل. وكيف أن الخطاب الإسلامي الجاري والغالب في مجتمعنا يكرر عقائد دوغمائية، دون أن يخضعها إلى تحليل تاريخي. ثم هناك النوع الثاني وسماه “الجهل المؤسس”، انطلاقا مما يحدث في النظام التربوي في مجتمعاتنا المغاربية منذ الاستقلال، حيث إن القائمين على النظام التربوي، والذين يتكلفون بتسييره واقتراح برامجه التربوية، يؤسسون للجهل.
إن الطموح الذي ظل ينشده محمد أركون في سياق قراءته للنص الديني، هو الخروج من أسر الإيديولوجيا التي ظل يلتف عنها الفكر الإسلامي، وتفكيك الأرثوذكسية الدينية والانفتاح على رحاب جديدة تشمل التجربة الدينية الإنسانية في كليتها. ولهذا فهو يعلن منذ البداية في قراءته، أنه لا ينخرط في الخط التبجيلي، ولا هو يريد اختزال النص الديني في مشروع أنثروبولوجي ولساني ولكن ضمن المشروع الفكري الكبير الذي أطلق عليه مشروع (نقد العقل الإسلامي).
إن أركون إذ يدعو إلى عقلانية جديدة، فإنه يرفض تسميتها بعقل ما بعد الحداثة مثلما يفعل العديد من فلاسفة أوربا وأمريكا، وإنما يخترع لها اسماً جديداً هو العقل الاستطلاعي الجديد المنبثق. وهذا العقل يشتمل على عقل الحداثة ويتجاوزه في آن معاً. بمعنى أنه ينتقد الحداثة ويغربلها لكي يطرح سلبيتها ولا يبقي إلا على إيجابياتها، ثم يشكل عقلانية أكثر اتساعاً ورحابة.
هذه العقلانية تتجاوز عقل التنوير بعد أن تستوعب مكتسباته الأكثر رسوخاً، ولا تحتقر الجانب الروحاني أو الرمزي من الإنسان كما كانت تفعل العقلانية الوضعية الظافرة منذ القرن التاسع عشر. العقل الانبثاقي هو مجال يتسع لكل الوقائع والأحداث والأفكار. إن العقل الذي نحلم بظهوره، في التصور الأركوني هو عقل تعددي، متعدد الأقطاب، متحرك، مقارن، انتهاكي، ثوري، تفكيكي، تركيبي، تأملي، ذو خيال واسع، شمولي، يهدف إلى مصاحبة أخطار العولمة ووعودها في كل السياقات الثقافية الحية حالياً، أي في كل الثقافات البشرية المعاصرة.
إن العقل المنبثق حديثاً يعتمد على نظرية التنازع بين التأويلات بدلاً من الدفـاع عن طريقة واحدة في التأويل والاستمرار فيها مع رفض الاعتراضات عليها حتى لو كانت وجيهة ومفيدة. يحذر العقل المنبثق الجديد من التورط مرة أخرى في بناء منظومة معرفية أصيلة ومؤصلة للحقيقة، لأنها سوف تؤدي لا محالة إلى تشكيل سياج دوغمائي مغلق من نوع السياجات التي يسعى هو بالذات للخروج منها. ومن ثم فهو يرفض خطاب المنظور الوحيد لكي يبقي المنظورات العديدة مفتوحة. وهذه هي أبرز ملامح عقل ما بعد الحداثة (العقل المنبثق الجديد) الذي يمثل غاية المشروع الأركوني.
بقلم: المصطفى عبدون