ومن شاء مثالا وجمالا ونضالا غير منقطع النظير”لقصيدة النثر” فهو الماغوط رائدها وعرابها ومعرّبها ولم يأت بها من غربها ولا شرقها بل أتت إليه مشتاقة تسعى إلى مشتاق من حبها وعشقها وعَرقها وأرقها ومن إقامتهما في “غرفة بملايين الجدران”!
**********************
بعض الكتابات – الشعرية – كممارسة العادة السرية. لا تصل أو توصل إلى الأورغازم ولا إلى الأرحام لإنتاج أجنة حية وتوليد معان ومبان، حقيقية ذات مصداقية، إلى المتلقي العاشق الذي يحاول هو الآخر الاستلذاذ أمام شاشة لعرض بعض الأفلام والأقلام الإيروتيكية والإباحية، ثم يخيّل أو يشبّه له أنه بالغ قمة الانتشاء أو واصل إلى ذروة الإبداع ونشوة الاستمتاع على نحو ما يسمى “بهزة الجماع” ورعشة الأورغازم!
بعض تلك الكتابات الشعرية كثيرة الادعاء بما ليس فيها، وعاجزة عن تحقيق المرتجى والمؤمل والمعول والمؤول منها مثل خلق الدهشة المبدعة والمفاجأة الممتعة أو ما سميته وجعلته في أحد الدواوين: “إهداء إلى شعراء وقراء الدهشة الأليفة والألفة المدهشة” – في زهرة الثلج 1998 –
ومن واجب مرسلها وحق مستقبلها ومتلقيها طرح الأسئلة عليها واقتراح الأجوبة عنها. الأسئلة والأجوبة لا تحصى ولكن الشخص العابر الغابر الظاهر يَهزّ الكتفَ ويَغُضُّ الطرفَ ويُعرضُ عنها، بل ويرفضُ الخوض فيها، خشية فقدان الإيمان بها، كإيمان العجائز، أو كمثل خوف شيخ جرة العسل من لمسها وانكسارها واندلاق عسلها عليه، رغم أنها جرة فارغة يملأ الدنيا ويشغل الناس رنين نحلها وطنين ذبابها “كالفَراش المبثوث” في كل وسائل التواصل الإبداعي والاجتماعي، والطباعي والسماعي، وعلى ألسنة جمهور الشعر و”النقد الشفوي” الأصدق إعلاما وأحكاما والأشد إيلاما من النقد المكتوب الكذوب.
ولكل معترض أن يصارح ذائقته: كم مرة فتحت على بعض تلك الكتابات –الشعرية – عينَها الراضية عنها وكم مرة أغمضت عينَها الساخطة عليها؟ وألم تَضق ذَائقتُه ذَرعاً بهامرة ولم تُطق ضائقتُه معها صبراً ولم ترَ ذاكرتُه لها عذراً ولم تُحِطبها حافظته خُبْراً؟
وذو السلعة والبدعة نفسه لا يعلم تنزيلها وتأويلها وغالبا ما يقول عنها: لا أدري، من الصعب علي الحديث عني ولا يصح لي شرح شعري. وكما سئل سلفها: “لم لا تقول ما يفهم”! سوف يرد خلفها: “لم لا تفهم ما يقال”! وقد قيل هذا لأبي تمام: إنه “كان ينحت من قلبه” وعنه “إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل”!
ومن يحاولِ الفهمَ لابد أن يصدمَ أو يُرمَى بالجهلِ – على الأقلِّ – إذا لم يرجم على عدمِ الفهمِ لكلامِ بعض الشُّثَّار الشُّطَّار من “مجانين العقلاء” كقول ابن حبيب النيسابوري أو بطلِه “بُهلولِ” الظريف الطريف الذي لم يردّ على قذف الأطفال له “بأحجار الأذى” إلا بالشفقة والعطف:
رُبّ رامٍ لي بأحجار الأذى،
لم أجد بداً من العطف عليهِ!
ولو تُعرضُ بعضُ تلك الكتابات الشعرية على صاغة النقد لخفّت موازينُها وبَخَست معادنُها المموَّهة وخَسّت ألوانُها المشوهة ولَمَا ساوَى ثمنُها شَرْوَى نَقير. وإذا ما مُدِّدت على مشرحة بنيوية أو مصحة نفسية أو أريكة تفكيكية شبيهة بسرير بروكوس تقاطعِ الطريق الأسطوري، واُمعِن فيها بتراً وتمطيطاً لأطراف زائدة أو ناقصة عن مقاس السريرعلى الجميع لما بقي منها شلو ولا عضو سليماً ومعافى.
ليس الغموض وحده ما يحول دون فهمها والإقبال عليها، فهو ضروري، ومنه الغموض، الفني، والمبهم، اللفظي، الذي سرعان ما يفهم، مهما شطّ في الخيال، من خلال ما يدل عليه ويشير إليه لغة وبلاغة وإيحاء وإيماء.
وثمة ما لا يمكن حصره من تلك الأمارات الموحية والإشارات الضوئية المرشدة والعلامات المرئية الهادية والخفية التجلي والجلية الخفاء، الواضح الغموض والغامض الوضوح، المنفتح الكون الشعري، على ما لا يُعدّ ولا يُحدّ من الصور اللغوية والبلاغية، الأسلوبية والتعبيرية، المجازية والاستعارية، الرمزية والأسطورية، التشكيلية والبصرية، التجريدية والعبيثة، الوجودية والصوفية، السينمائية والسيميائية، والسوريالية الخارقة والفائقة الواقع والخيال الممكن والمحال، ولكنها واعية أو غير واعية بصيرة بكل شيء، في الحياة والوجود والعالم والإنسان، ولا تخبط خبط عشواء وشعواء، ولا تحطب في ليل ولا حبل ولا تخطب ود أو يد رجل وتطلب منه طلاق أختها أو ضرتها لتنفرد به. ودائما ما تترك حبل رجاء وخيط أمل، سواء كان طويلا أم قصيرا، فإنه قرينة دالة مرسلة ومستقبلة للتواصل والتراسل معها ولا تلقي بالعاشق المتلقي في خضم اليم مغمض العينين ومكتوف اليدين ومقيد القدمين وتقول له إياك أن تبتل بالماء.
ولكن هناك من الغموض ما هو مفتعل ومصطنع وموغل في التعمية والتدجيل والتكلف والتضليل، كالسالك الضائع داخل متاهة لابِيرانْتْ لا تفضي إلا إليها.
إن الغموض المفتعل والمصطنع والمتكلف والشائع كالقمّل والصئبان في شَعر “باروكة” بعض تلك الكتابات أشبه ما يكون “بلعبة الغُمّيضة” اللاعب الوحيد فيها الكاتب نفسه، ومن يحاول فهم قواعد اللعب والقبضَ على رأس الخيط فليضرب برأسه عُرض “الحيط”! فهي تلقي بالعاشق المتلقي في بئر لا قاع لها ولا قرار ومتاهة لابيرانت لا تعرف لها مدخلا ولا مخرجا وتتعمد السير فيها على غير هدى ولا تدري ولا تريد أن تعرف لا أين ولا كيف السبيل للخروج من المتاهة والبئر ولا يَشغَلها غير تَكرار واجترار وتَرداد نفس الكلام المُعار والمُعاد الذي سئم منه كعب بن زهير مع زوجته الثرثارة:
ما أرانا نقول إلا معارا – أو رجيعا –
ومعادا من قولنا مكرورا!
كذلك يبدو هذا الشاهد الشعري والنقدي شبيها بأسلوب الذم الذي يراد به تأكيد المدح لها وتغدو من قبيل تَكرار وتَعداد الكلام الجميل المُعار والمُعاد وكأنه تَرجُومٌ لنصوص غائبة وحاضرة وتَرجيع لأصوات وأصداء وإيقاعات أخري، ولها أشباه ونظائر شتى في مشاهدها وصورها الغريبة المغرَّبة أكثر مما هي معرَّبة والمعارة والمعادة والمهرَّبة من غير طبيعتها وطباع أهاليها.
وبالتالي فإن “رِيحتها كتسبق سِيفتها” وفي “سِيفَتِها وسِيفِيهاcv” يشيرُ الكثيرُ من مساحيقها وأصباغها وتزويقها وتنميقها وتغميضها كإطباقها لمآقيها في خشوع صلاة الوداع وركوع الجماع، إلى أن “حسنها مجلوب” و”فنها مڭلوب أو مجذوب” وفيها من “حسن الحضارة والبداوة” ما ينافي ويجافي فعال وخصال قائليها ومنتحليها، وينم عن سر تفريطها في البالي القديم “اللي له جِدة” وعدم انخراطها الكلي في الحديث الجديد العصري، ويكشف عن وجه تحبيذها تقليد التجديد – الحداثي التراثي – ونبذها تجديد التقليد – التراثي الحداثي – على حد قول أبي الطيب المتنبي:
حسن الحضارة مجلوب بتطرية،
وفي البداوة حسن غير مجلوب!
وما الحسن في وجه الفتى شرفا له،
إذا لم يكن في فعله والخلائقِ!
و في “لعبة الغميضة” يحضر الغياب: لا معنى لأي شيء، لا وقع ولا جدوى، لا قضية كبرى أو صغرى، لا رسو على بر ولا بحر، لا هو شعر ولا هي نثر، لا قاع لإيقاع، عينك ميزانك، وزنك أذنك، لا وجود لواقع، لا غاية لحياة، ولا معالم لعالم ولا هدف لطريق تماما على مذهب الشيخ الحكيم ابن الرومي الذي لم ير غاية لطريق ولا لرفيق:
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي،
ومن أين والغايات بعد المذاهبِ!
ومن قواعد اللعبة المطلوبة والمرغوبة والمحبوبة في بعض تلك الكتابات الطائفية الخارجة عن “المواطنية الشِّثْرية”proême – التلاعبُ بالألفاظ – على أن تعتمر طاقية الإخفاء، وتتقن الاختباء، وتحسن الخداع، وتجيد سلاطة اللسان الطويل، وتنظر من وراء حجاب، نظرا شزرا، وتسفر عن سخطها وتبالغ في شططها وولائها لمقدساتها ومهادنتها لسلطها ودفاعها عن غلطها وتجعل من الفوضى نظاما ومن نظام التفاهة والمجانية والعبثية والاعتباطية واللامعقول سبيلا إلى اللاوعي واللاشعور وطريقا إلى المصير المجهول وحتى من التنافر والركاكة والفانتازية أسلوبية غرائبية وعجائبية بهلوانية، والبهلوانية والهلوسة أيضا تعد فنية.

والأهم من كل ذلك أن تحكم إغلاق فيها وإغماض عينيها ولا تنظر إلا إليها ولا تنطق إلا بما لا يعنيها وأن تدخل عاشقها ومتلقيها في متاهتها وأن تضعه أمام وحشها الخرافي الأسطوري المينوطوري، كالأمير البطل ثيسيوس ولكن بلا سيف ولا كبة خيط الحبيبة أريادني، وتتركه تائها هناك حيث لا حياة لمن ينادي،لا نجاة له من الموت ولا يستطيع حتى وصولا إليه.
وبالمختصر المفيد فهي منطقة مجردة ومنزوعة من السلاح محايدة ومستقيلة من هنا والآن و”هيا إلى الكفاح ويا رفيق ارتاح ارتاح ما زلنا على الطريق” وغيرها من الشعارات والهتافات الخطابية والتقريرية الإيديولوجية الفجة والمتجاوزة والعاجزة وهي وحدها ربة معجزة الزمان، وعشبة الخلود، وهِبة الفضاء والفراغ والخواء والخلاء، وعبقرية الدهر، والقادمة من المستقبل، والمراهنة عليه والساكنة فيه، والمصادرة والمحتكرة والمحتقرة لحق أهله، والناطقة الرسمية باسم حرية أجياله، الفارضة عليه أذواقه والرافضة منه أخلاقه، وهو مستقبل الأحلام الماضية والآنية والفانية، في ماضي الأيام الآتية. وليس بالإمكان أبدع منها ومن يبتغي غيرها شعرا وقصيدة ونثرا، فهو في عقيدتها مجرد باطل وقبض ريح. وإن كان لابد من ربح، فهو خسران العالم “والعصر إن الإنسان لفي خسر” على حد إيمانها بقول الكتاب المقدس: “ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه” والمصحفِ الشريفِ: “يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم” ولذلك اتخذت من ذاتها المقدسة محورا ومركزا ومدارا لكونها الشعري.
ومن شروط هذه اللعبة و”الشعوذة اللفظية” في بعض تلك الكتابات الشعرية أنه – استئناسا هنا أيضا بتعابير كتاب السيدة الفاضلة سوزان بيرنار وتعاليمها وحكمها: “لا أهمية للموضوع” بل لا ينبغي لها أن تكون إلا “خارج الموضوع” وأن لا تقود إلا إلى “طريق مسدود لأن ذلك بالتحديد منطقَها الشعري” وهو “الضرورة الفوضوية” و”كل ما يحطم التصنيفات العقلانية كما تحملنا إلى عالم آخر هو فوضوية محررة”. ولكن هذا “العالم الآخر!” ليس إلا في ثورية دنيا الحياة وحرية عليا الحياة المفقودة والمنشودة الجمال، المنقذ وحده لنفسه وللعالم كله من ضلاله المبين بنضال الجمال وجمال النضال، تماما كما تقول مدام سوزان بيرنار في”قصيدة النثر” وعنها إنها: “النضال المتواصل للإنسان ضد مصيره أكثر من كونها محاولة لتجديد الشكل الشعري”!
وهذه العبارة وحدها أصح “بيان للناس” وأفصح “مانيفيست” لكل لسان وعنوان وديوان من الشعر العالمي.
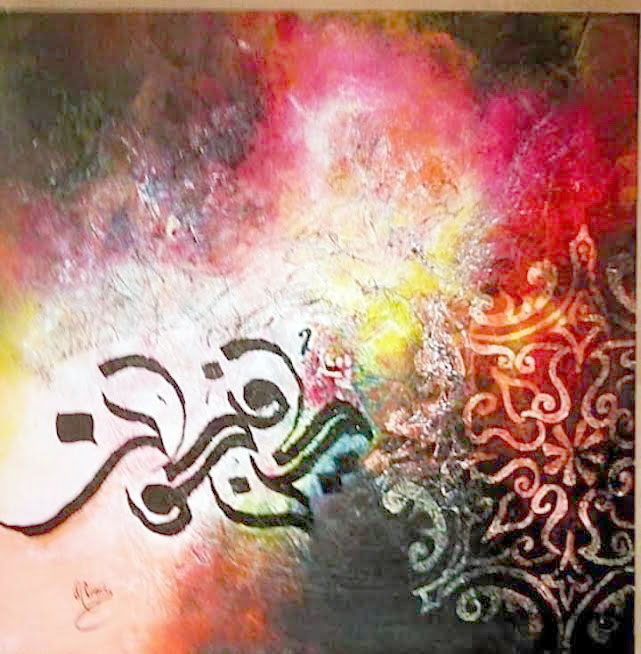 وليست هناك كتابة ولا تجربة ولا لعبة خالية تماما من أية نظرية تنبع منها وتصب فيها قواعدُها المستنبطة والمرتبطة بها كارتباط “ثمار براري النثر وبحار الشعر” بشجرة المعرفة والحياة، التي لا يستطيع أي كائن فيها، شخصي أو نصي، الاكتفاء الذاتي، أو العيش دون احترام حسن الجوار وفن الحوار وحق الخيار والقرار والبقاء على قيد الحياة والوجود لكل أنواع الإبداع والإمتاع والإشباع والإرواء الإلهي والطبيعي والإنساني.
وليست هناك كتابة ولا تجربة ولا لعبة خالية تماما من أية نظرية تنبع منها وتصب فيها قواعدُها المستنبطة والمرتبطة بها كارتباط “ثمار براري النثر وبحار الشعر” بشجرة المعرفة والحياة، التي لا يستطيع أي كائن فيها، شخصي أو نصي، الاكتفاء الذاتي، أو العيش دون احترام حسن الجوار وفن الحوار وحق الخيار والقرار والبقاء على قيد الحياة والوجود لكل أنواع الإبداع والإمتاع والإشباع والإرواء الإلهي والطبيعي والإنساني.
والكتابةُ والغدُ الآنَ، “لأنَّ الغدَ يهتمُّ بنفسه، يكفي اليومَ شرُّهُ” على حد بشارة الإنجيل وشرارة الشاعرة إيتيل عدنان: “أيها الشعراء، غيروا العالم أو اذهبوا إلى بيوتكم”!
ومن شاء مثالا وجمالا ونضالا غير منقطع النظير “لقصيدة النثر” فهو الماغوط رائدها وعرّابها ومعرّبها ولم يأت بها من غربها ولا شرقها بل أتت إليه مشتاقة تسعى إلى مشتاق من حبها وعشقها وعَرقها وأرقها ومن إقامتهما في “غرفة بملايين الجدران”!
ومع ذلك “لا يتم الحكم على شاعر بما يدمره، بل بما يخلقه” و”لا ينبغي للمتلاعب، هنا أيضا، أن يخفي علينا رمزَهُ”. هذا إذا لم يُبد غَمْزَهُ بالخَلْق وعجزَهُ عن الخَلْق لمحاً وإشارة، وتصريحاً وتقديرا كذلك من “حُكّام” اللعبة و”حراس” شِباكها ومرماها وأهدافها الصائبة والمصيبة بالضربة السديدة، كهذه الحكمة الرشيدة لإميل سيوران القائل إن المرء عندما يضمر أو يظهر: “كرها لأحد يعطي الدليل على أنه جدير به” و”المياه كلها بلون الغرق”! فانتبه “واه داك الغافلْ”!
وهناك من القرائن ما يدلّ على أن كثيرا من هؤلئك المتحذلقين المتحدثين عن “مدام غيران” أو السيدة سوزان بيرنار لم يروها طبعا ولم يسمعوها قطعا ولم يشربوا من كتابها نصفا ولا ربعا.
وهي بالتالي “لعبة غميضة” مفتقرة إلى “التقنية الشعرية” و”الكشف عما هو خبيء في الواقع”. بل ومفتقدة فرضاً أو رفضاً لفكر النظر العزيز والحريز الرقية والرؤية والرؤيا إلى دنيا الحياة الحقيرة الحال وعلياها السعيدة المَآل المُخال أو المُحال!
وهي حتى هنا والآن تجيد “التلاعب بالألفاظ” ولكنها عاجزة عن اجتراح التجريبي التخريبي والتنويري التثويري، والمغامرة المغايرة، وما لها من اختراق الآفاق وأخلاق النفاق غير الاختلاق وإطلاق العنان لعقيرتها في كيل المديح لعقيدتها والنيل من عقدتها الدائمة اللازمة في هجائيتها “لوثنية الوزن” وبكائيتها على “شيخوخة الخليل” وانتشائيتها بإنشائيتها وبغض عروض القريض الخليلي والإخفشي والتّحرش الطائفي الشعري والنقدي. و”اللي حاذْغَا فيه” أكثر من أي شعر ونثر وشيء آخر هو “تَخْصارْ الهدرة” و”التّحواسْ عْلى الزّْغَا” عَلى حدّ هذا التعبير الوجدي.
وغني عن البيان أن المعني بهذا التبيين ليس إلا كلُّ همزة لمزة ومشاء بنميم وعُتلّ زنيم وأقلُّ كثيرا أو أكثرُ قليلا من “تسعة رهط يفسدون في الأرض و لا يصلحون” للقصيدة نثرا ولا شعرا ولا نقدا ولا ودا وهلمّ جرّا بين مُقفرة وأخرى على حد وصف الشاعر عائد بن يزيد اليشكري القائل الأول “لهلمّ جرّا” بهذا المثل عن سفره الطويل في المفاوز والفيافي المقفرة المهلكة:
فإن جاوزت مقفرة رمت بي،
إلى أخرى كتلك هلمّ جرّا!
< بقلم: إدريس الملياني
