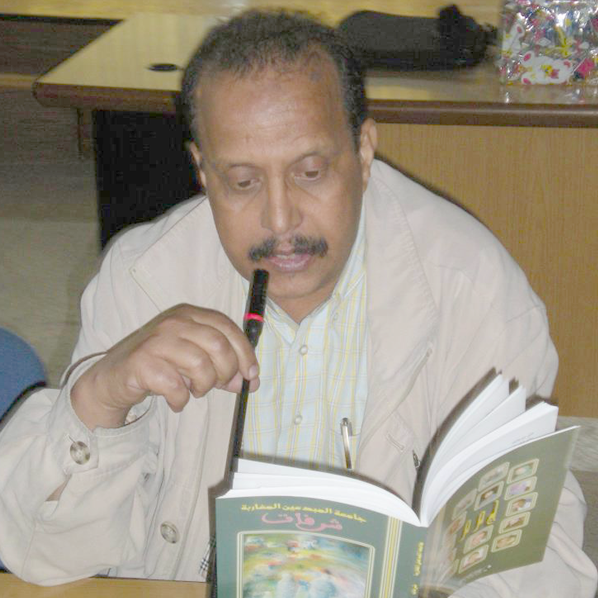كتبت قصائد ديوان “لأحلام النورس الأخير” الصادر عن مطبعة بلال 2015، لحسن الرموتي بين 1986-2014، وهي قصائد تحتفي أيما احتفاء بالهامش الإنساني المبعد، وذلك من خلال إعادة تشكيل نداءات الذاكرة القريبة منها والبعيدة. ويستثمر حسن الرموتي لأجل ذلك رموزا أسطورية ونماذج شعرية ذات أبعاد إنسانية وثقافية (طائر الفينيق، عروة بن الورد..)؛ بحيث تتشكل دلالة رمز الفينيق الثقافية في الديوان باستحضار نداء الشاعر الإسباني المقتول غارثيا لوركا، ومن ثمة توسيع إمكانية الرمز ليستحضر أرواح شعراء مقتولين دون الاستناد إلى تمييز جغرافي أو ثقافي محدد. وهذا ما يتبناه كذلك في استحضاره لنداء عروة بن الورد الذي ينتقد من خلاله النزعة القبائلية التي لا تعترف بالأصوات المصنفة خارج إطار المركز/ النزعة القبائلية التي تتعالى عن روح الأمة وعن معاناة الآخر ضاربة عرض النسيان وجود الهامش.
وفي هذا السياق بالذات، تشكل قصائد ديوان “لأحلام النورس الأخير” ثقافة مضادة لثقافة التمثيل/ التهميش، الاستفحال والاستحواذ الثقافي. ويكفينا، لنؤكد هذا الأمر، أن نتأمل، مثلا، حضور “النورس” في قصائد الديوان، نعتبره في هذا السياق صوتا مركزيا يحيل إلى ذوات إنسانية متشظية، ليتبين لنا بالملموس أن توظيف هذا الطائر لا يروم من خلاله الشاعر الحديث عن طائر وحسب، وإنما يراهن، عكس ذلك، على التعدد الدلالي، بما هو رجوع باللفظ إلى أصل واحد مع إحالته على معاني متعددة ترتبط بأصل/ مرجع كما يؤكد ذلك ستيفن أولمان (دور الكلمة في اللغة، ص132). ونفترض تبعا لذلك، أن أصل/مرجعية استخدام النورس هو نداء الهامش، وأنه يحيل دلاليا إلى الكيانات المهمشة كما نجد في الديوان (الأطفال اليتامى- الأمومة المنسية- البحارون الغرقى- المرافئ الحزينة- ماسحو الأحذية…). ومن ثمة فالنورس يحيل إلى ذوات مبعدة في واقع متناقض. ولئن كان موقف النورس أن يحلق عكس الريح، كما سنقرأ في القصيدة/ العتبة (أحلام النورس الأخير)، احتجاجا ورفضا للواقع، فإن نهايته المأساوية ذات دلالات ثقافية متعددة؛
“وحدها النوارس
تحلق عكس الريح
في موكادور
وحدها النوارس
تدرك سر الغياب
وتموت على مهل ..” ص 11
النورس في الديوان مفرد بصيغة الجمع، يحيل إلى ذوات تقيدها المؤسسات وتلغيها. ولأن الفرد محكوم ببنية مجتمعية آستهلاكية مركزية، فإن تمايزات قصائد الديوان اللفظية تمثل لتمايزات ذهنية وثقافية محيلة على تلك البنية، وما يدل على تلك التمايزات في الأسطر السابقة نجد (التحليق عكس الريح- إدراك سر الغياب- الموت على مهل) وهي تمايزات تصور واقعا مشتركا لا يحده المكان (موكادور) لأنه يحيل إلى أصل/ هم مشترك؛ وهو الهامش المنبوذ والمنسي. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن قصائد الديوان، كما أشرنا سابقا، تستند إلى بعض الأصوات المنسية؛ كصوت الأم، وهذا ما تمثله قصيدة “الأم” مثلا التي تسخر من بنية ثقافية سادية تبعد كل أسباب التعايش والاعتراف. فالأم، بما هي رمز للخصب، الحب والحياة، تعيش على حافة الواقع، تتابع مجمل التحولات الكئيبة لكائنات الطبيعة؛ تحولات هي جزء منها لانتمائها إلى بنية إبعادية ومادية/ آستهلاكية. وليس هذا فحسب بل إن كائنات الديوان وآستنادا إلى هذا المناخ الثقافي العام تتلاشى، مكرهة، وظيفتها الأصيلة فيها؛ بحيث إن القمر، في قصائد الديوان، لم يعد قمرا يضيء والحصان ترك وحيدا والعشاق تائهون والعصافير جريحة والأزهار تصارع مخاضها، وماء الجب نضب.. ولأن الشاعر/ الذات والصوت ينتمي إلى هذه البنية، فإن ذاكرته القريبة تستحضر تلك التحولات العنيفة، ومن خلالها يستحضر علاقته الوجودية بفضاءات أخرى دالة:
“هناك على التل قبر جدي
يحرس العشب والجسر الوحيد نحو النهر
يدرب قلبه على الصبر والمنفى
على الرحيل الأخير
على الفرس المعتكف وحيدا
لا أحد يسرجه الآن سوى.. الانتظار ..”(ص 14)
إن هذا الانحياز الواعي إلى الأمكنة الفائضة، الذوات/ الكيانات المبعدة لا يعد آحتماء بالهامش وإنما هو آحتفاء ومواجهة لواقع ثقافي ومجتمعي متناقض. وإعادة تشكيل الحدث والبنى يكتسي أهمية تاريخية وقرائية على حد سواء؛ بحيث إن فعل إعادة التشكيل يستدعي عند القارئ مجمل التجارب الحياتية، بل ويلفت إليها الاهتمام ويعطيها أهمية ثقافية عبر مساءلة الذات وتنبيهها إلى أحداث أصبحت عادية جدا بفعل الآستهلاك اليومي لها. ومن أجل ذلك لا يتوقف حسن الرموتي في عملية إعادة التشكيل عند أحداث تاريخية معينة أو أفراد من فئات عمرية مختلفة “الأم”، “البحار”، “الطفل”، “الجد” بأسلوب شعري عاطفي أو يروم إيقاعا كذلك.. وإنما يعمد إلى آستحضار نماذج شعرية من التراث للإحالة على تلك الوقائع. وهذا التوظيف الشعري للتراث والأسطورة له أهميته الجمالية والثقافية كذلك. إذ نلاحظ في الديوان أن التجارب الفردية تتعايش مع النماذج التراثية والأسطورية العليا بما هي بنيات فوقية للتحدي ولإعادة الأمل وبعث الحياة من جديد. ومن الأمثلة الدالة في هذا الإطار قصيدة “عروة زمن الصعلكة”:
“البيد يوما لم تساومك
فرسك لم يسرجه سواك
لم تدجنه شيوخ القبيلة
وكما الريح
لم تنحن سوى للنخلة السامقة
وفي مواسم الجدب
دوما تفكر بالعيون الظامئة..” ص78
يستثمر حسن الرموتي تجربته الشعرية/ الجمالية والثقافية ليفضح المؤسسة/ المركز وما يمارسه من طمس للذاكرة وللذات على حد سواء؛ وذلك من خلال تجارب شعرية/ ثقافية فارقة كتجربة عروة بن الورد، بإعادة تدوير تاريخ هذا الشاعر وثقافته ومناهضته للاستبداد والاحتواء القبلي. وتتجلى أهمية تضمين النماذج الشعرية/ التراثية كعروة والنماذج الأسطورية كطائر الفينيق في قلب الحقائق الراسخة والمكرسة، دفاعا عن حياة مختلفة تنادي بالبعث والتحدي، ضد الاحتواء القبلي الذي يشكل صورة لاحتواء/ تحكم المؤسسات. لهذا فلا غرابة أن يشكل بعث الفينيق في قصيدة (وصية لطائر الفينيق) تلبية لنداء بعيد:
“يوقدني صوت رامبو
براءة طرفة
دم لوركا…
أنا الطائر المتيم
بعشق الموت
والموت صباي
حين أرتشف قلق الأرض
تزهر في المقل كؤرس الأحبة..” (ص44)
إن هذا التوظيف بله التشخيص الإنساني لطائر أسطوري دليل على أن الرمز التراثي والأسطوري يشكل إمكانية لقلب الكثير من الحقائق قراءة ومراجعة وإعادة تشكيل؛ بحيث يشكل بعث الفينيق وعروة، بعثا للأمل ولقيم الحياة المؤجلة. وفي هذا السياق يمكن أن نرصد لتحول آخر في وظيفة الشعر؛ تحول من شعرية الذاكرة وما تقتضيه من مراجعة للحقائق، إلى شعرية المواجهة، آنتصارا للهامش المبعد، لوظيفة الشعر المؤسسة على الالتزام بقضايا المجتمع، لتتحول بذلك هذه القضايا إلى أثر صامد ومنفتح، في آن، ماثلة دوما في النص، شاهدة على ما يمارس ضد الذات والهامش من آنتهاكات بآسم الثقافة والحداثة. ولهذا كانت الذكريات قابلة لإعادة التشكل عند القارئ من خلال النص الشعري، وذلك عبر التذكر الإرادي بما هو، في الغالب، قراءة نقدية مسائلة للذات، وليس عبر الذكرى بما هي إعادة لماض وليس تحسرا وشوقا. وهنا يكمن الفرق فالتذكر، في الغالب، باعثه ثقافي، قراءة منفتحة على جميع القضايا المبعدة بموجب تحفيز أو تحريض كيفما كان نوعه. ولا يمكن أن تقوم القصيدة، المؤسسة على شعرية الذاكرة/ التذكر، بهذا الدور الثقافي إلا من خلال المسافة التي يقيمها الشاعر مع الذات آنتصارا للهامش، لطالما أن الحياة هي الشعر حين تكتبه ذات ليست ذاتية تماما كما يعبر عن ذلك محمود درويش.
بقلم: عبد الرزاق هيضراني