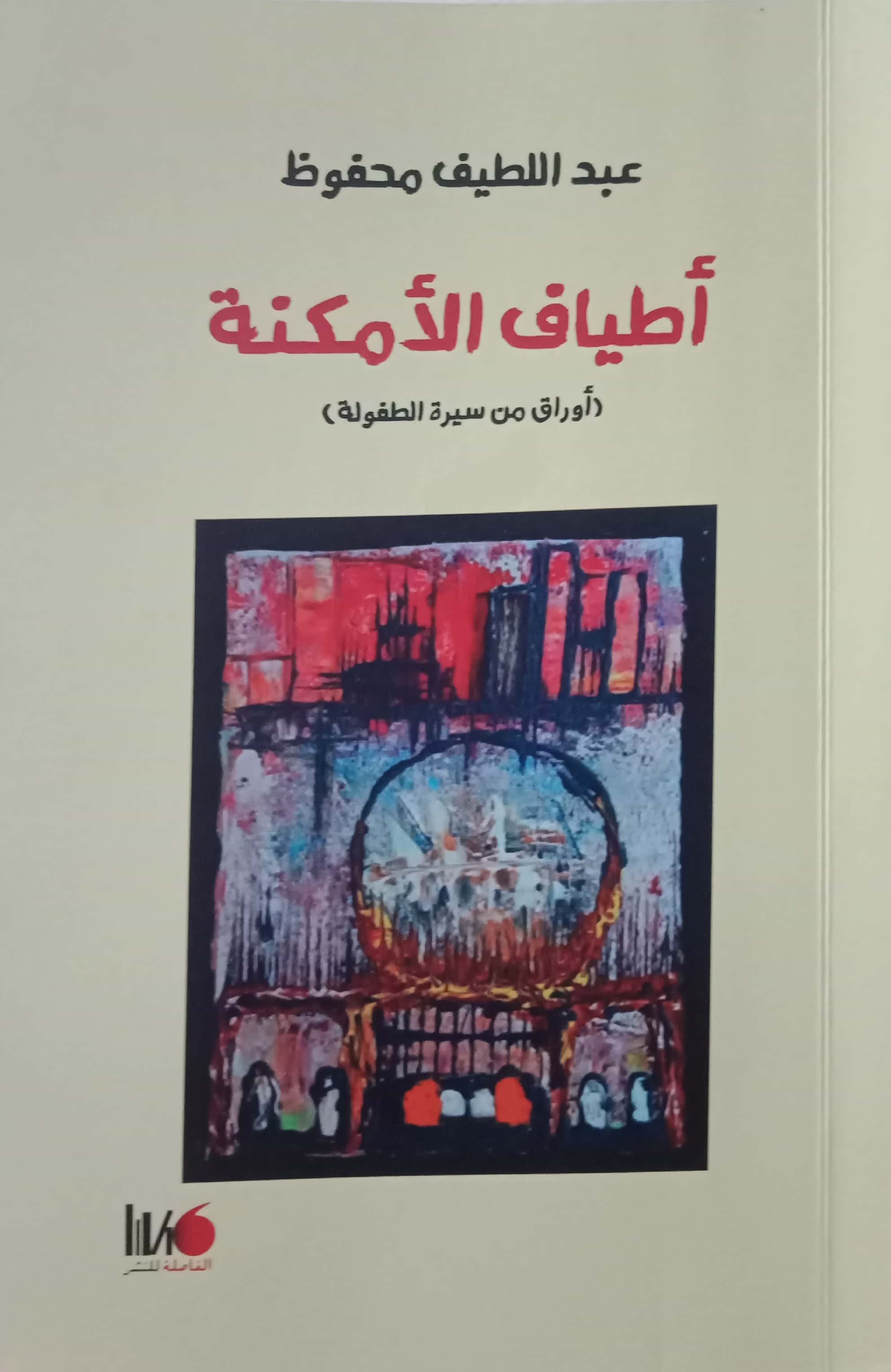تعكس التجربة الإبداعية لعبد اللطيف محفوظ ارتباطا وجدانيا عميقا بالمكان، فالقارئ لـ “رهاب متعدد” و”وادي اللبن” سيلاحظ ما للمكان من سلطة وتأثير كبيرين على محفوظ.. ففي سيرة طفولته “رهاب متعدد”، يلاحظ أنه حتى وإن كان الرهاب هو المحور النصي لهذه السيرة التخييلية، إلا أن المساحة التي احتلها المكان فيها كانت لافتة للنظر، فمدينة فاس كانت حاضرة وبقوة بدروبها وساحاتها وأحيائها وحدائقها، لذلك جاز أن تعد سيرة مكان إلى جانب كونها سيرة طفولة. وقد ظل الاحتفال بالمكان يلاحق محفوظ في روايته “وادي اللبن” كذلك، فهذه الأخيرة بمحاكمتها للتاريخ، كانت تروم تحقيق الإنصاف، إنصاف التاريخ المشرف لتيسة الذي غبنه المؤرخون حقه، وإنصاف تيسة تحديدا، مسقط رأس عبد اللطيف محفوظ.
القارئ لهذين العملين إذن، سيلاحظ الحضور المكثف للمكان إلى حد يتحول فيه هذا المكان إلى طيف ما ينفك يطرق خياله ويلاحقه في سروده، وهو تصور يجد ما يؤيده في العنوان الذي وسم به محفوظ روايته السيرذاتية “أطياف الأمكنة”، فمثلما طيف المحبوبة يتلبس المحب، لا يزاور عن فكره، كذلك أطياف الأمكنة تسكن محفوظ لا تغادره.
الأطياف.. من يطارد من؟
لقد عمل عبد اللطيف محفوظ على أنسنة المكان، بحيث حوله إلى كائن حي هو الإنسان من خلال استعارة إحدى خصائصه “الطيف”، فالأمكنة عند محفوظ تتحول إلى شخوص تألف وتؤلف، وتنسج بينها وبينه خيوط محبة لا تشيخ، لذلك يظل طيفها يلاحقه حين مغادرته لها، لا يستطيع لها دفعا، ولا يملك منها خلاصا ولا فكاكا.
يتحول المكان إذن في هذا العمل التخييلي إلى كائن له القدرة على أن يحضن وأن يشعر بالدفء، وأن يتصف بالحنان حينا وبالقسوة حينا آخر.
يمكننا إذن أن نتخذ من العنوان علامة نستطيع أن نقرأ من خلالها هذه السيرة التخييلية، وأن نستدل من خلالها على المحور النصي للعمل ككل.
اختار عبد اللطيف محفوظ أن يتخذ من الطيف عنوانا، غير أن الطيف هنا جاء مسندا إلى المكان وهو ما لا يستقيم، أي أن العنوان قد تم الجمع فيه بين ما هو مجرد وما هو محسوس، مما يشوش على القارئ ويخلق لديه نوعا من الحيرة والارتباك، فالطيف حسب التحديد المعجمي هو الخيال والشبح، ومعلوم أن الجماد لا شبح ولا خيال له، فذلك من خصائص الإنسان. فكيف أمكن لمحفوظ إذن أن يجمع بين النقيضين؟
الإجابة عن هذا السؤال تستدعي مشاركة تأويلية من القارئ، الذي سيكون عليه الانتقال من القاموس إلى الموسوعة حتى يرفع هذا اللبس، وفي هذه الحالة، ستحيلنا المدونة على مجموعة من السيناريوهات التناصية التي تربط المكان بساكنه، كما ستحيلنا على مجموعة من العبارات المسكوكة التي تسير في نفس الاتجاه والتي تجعل سومة المكان تحدد بساكنيه، فالمكان إذن غالبا ما يستعار للكناية عن ساكنيه. وما وقوف الشعراء على الأطلال وبكاؤهم على الديار إلا تأكيد لهذا الطرح، وهو ما أعلن عنه قيس بن الملوح صراحة بقوله:
أمر على الديار ديار ليلى
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديارا
إن المكان بوجود ساكنيه يمنح إحساسا بالدفء والمحبة والألفة، وبغيابهم تتغير معالمه، فتصبح المقومات التي تفسره هي: [+موحش] [+مهجور] [+بارد] [+مظلم] [ -مؤنس] إلى غير ذلك من المقومات السلبية.
هكذا إذن تتحول أطياف الأمكنة إلى أطياف ساكني الأمكنة، فالأمكنة وساكنوها يتنافذون فيما بينهم.
هذه إذن هي الصورة التي علقت وترسخت في ثقافتنا عن علاقة المكان بساكنه، ومن الواضح جدا أن عبد اللطيف محفوظ قد استحضر هذا عند وضعه للعنوان.
ويمكننا أن نسلك مسارا تأويليا آخر لتحليل دلالة ربط الطيف بالمكان وذلك انطلاقا من مقومات الطيف نفسه: ِ[+ منفلت] [+زئبقي] [+متخيل] [-حقيقي]، فإذا كان من مقومات المكان الثبات، فإن من مقومات الطيف الزئبقية والانفلات. إنها الحقيقة مقابل الوهم والخيال، ومن تمة يغدو محفوظ مطارِدا ومطارَدا في الآن نفسه، فهو حين يشتد عليه الحنين إلى أماكن بعينها وتطارده أطيافها، فإنه ينطلق مطاردا لها محاولا استرجاعها والإمساك بها، لكنه عبثا يحاول، إذ سرعان ما تنفلت منه.
تحيلنا هذه الصورة على الخلفية الباشلارية والتصور الباشلاري للمكان المنفلت من قبضتنا، فالمكان عند غاستون باشلار كالطيف لا يمكن الإمساك به، حتى الذاكرة يستعصي ويتعذر عليها ذلك. ولما كانت التجربة الحسية عاجزة عن إحكام قبضتها على المكان، كان التخييل هو الإمكانية الوحيدة لتحقيق ذلك. هكذا نجد عبد اللطيف محفوظ ينجز مع القارئ ميثاقا تعاقديا تم الاتفاق فيه على أن القارئ إزاء أوراق من سيرة الطفولة، فكأن “أطياف الأمكنة” امتداد لسيرة الطفولة “رهاب متعدد”، وهو ما يزكي الفرضية التي انطلقنا منها، فكأن محفوظ قد أعلن رضوخه واستسلامه لأطياف الأمكنة التي ظلت تلاحقه في عمليه السابقين. فإذا كان حضور المكان مضمرا في “رهاب متعدد” وفي “وادي اللبن”، فإنه صريح معلن عنه في “أطياف الأمكنة”.
بأفق التلقي هذا ينطلق القارئ في تتبع أطياف الأمكنة، فسيرة الطفولة المجتزأة هذه – إن صح التعبير- تعمل على تبئير العلامة اللغوية “أطياف” التي يستحضر معها الأفق الذي ارتبط بالأمكنة، وما يؤكد أفق التلقي هذا هو افتتاح محفوظ أوراق سيرته بـ “تيسة” مسقط رأسه: “على خلاف معظم إخوتي الكبار، ولدت بعاصمة قبيلة الحياينة الهلالية (تيسة)” حيث اختار تقديمها عبر لقبها “عاصمة الخيول” وعبر كائناتها الجميلة.

عبد اللطيف محفوظ
أول مكان يقف عنده السارد إذن وأول طيف يزوره هو “تيسة: عاصمة الخيول”، وسنتوقف هنا عند هذا الكائن “الجميل”، كعلامة من مقوماتها: [+ أصيل] [+شجاع] [+ ذكي] [+خير]… وإذا ما قمنا بتبئير هذا المقوم الأخير أي صفة الخير، فإن الموسوعة الثقافية للقارئ ستحيله مباشرة على الحديث النبوي الذي يقول فيه (ص): “الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”، وبما أن “تيسة” عاصمة الخيول، وبما أن الخيل معقل الخير، فإن “تيسة” تصبح عاصمة الخير أيضا ومربطه.
“تيسة” إلى جانب كونها عاصمة الخيل والخير، فهي عاصمة الجمال كذلك، هذا ما نستخلصه من العنوان الفرعي “كائنات تيسة الجميلة”، فالجمال هنا يجوز أن يكون صفة لـ “تيسة”: “كائنات تيسةَ الجميلةِ”، كما يجوز أن يكون صفة لتلك الكائنات (الخيول): “كائنات تيسةَ الجميلة”، وبالتالي فـ “تيسة” بعيني قلب عبد اللطيف محفوظ جميلة في كل حالاتها، سواء نسب الجمال إليها أو إلى كائناتها.
الحب كل الحب لبلاك العزيز
يبدو أن الحديث عن “تيسة” حديث ذو شجون، فمن “تيسة” إلى كائناتها الجميلة إلى العزيز بلاك وزوجي اللقلق. هكذا إذن جاءت الأطياف مرتبة، فبعد “تيسة” مسقط الرأس، يطل علينا الكلب بلاك من غياهب ذاكرة محفوظ، حيث اختار تقديمه بطريقة مختلفة تماما عن تقديم “تيسة”، بل إنه لم يطق صبرا حتى الفصل المخصص لبلاك ليقدمه للقارئ، حيث اختتم فصل الخيول بالحديث عن بلاك وعن حبه الجم له: “كان حبي له يفوق ما نسمعه الآن عن حب الغربيين لكلابهم. وكان حبه لي أيضا فوق الوصف. كنت أحس بذلك الحب في بلاغة تعبيره بالحركات والأصوات، وهو الحب الذي جعل سيرته، كلما تذكرت طفولتي الأولى قبل سن التمدرس، تتصدر شريط الذكريات، تتلوها سيرة زوج اللقلق الذي دأب على الإقامة في عش فوق سطح بيتنا”.
لقد جاء حديثه عن بلاك حديثا بشحنة عاطفية قوية صادقة، تعكسها لفظة “الحب” التي تكررت أكثر من مرة في هذا المقطع، فبالحب وبالحب وحده يتحدث عن بلاك، حتى إن هذا المقطع يمكننا أن نعده شهادة حب في حق بلاك، فكل سطر فيها لم يخل من كلمة حب.
حب السارد لبلاك وتعلقه الشديد به، جعل العنوان يأتي على شكل مناجاة، فهو يناجي طيف الراحل بلاك: “بلاك أيها العزيز”، بل ويرفعه إلى منزلة الإنسان، فالصفات التي أضفاها محفوظ عليه، جعلت الكلب بلاك يكتسب هوية إنسانية، فهو مرهف الحس، رزين، ذكي، حقود أحيانا، له القدرة على التمييز والتحليل، شهم، غفور كذلك وحليم. يقول المؤلف:
“كان بلاك كلبا ذكيا ذا شعور مرهف مثل إنسان حساس، يتعامل برزانة عالم، ويحرس بهمة فارس مخلص، ويتعصب بحقد متطرف، والآن وأنا أذكره أستبعد أن يكون حيوانا إلا بهيئته……… كان يغفر لي زلاتي الكثيرة غير المقصودة…… وبنفس الحلم والتفهم كان يعامل جارتنا الكفيفة “منانة”…… كان حليما، يقدر غياب العقل وإكراه الإعاقة، لكنه صارم في حقده على من جار علينا”.
يمكننا القول إن هذا المقطع وحده كفيل بأن يلخص تلك العاطفة الجياشة البركانية التي يحسها ويكنها للعزيز بلاك، كلبه الذي كاد يجزم أنه لم يكن حيوانا إلا بهيئته.
وداعا “تيسة”، بالأحضان يا فاس يا بلاد الأسلاف
أوراق سيرة الطفولة هذه إذن هي محطات فارقة في حياة عبد اللطيف محفوظ، ولعل أبرزها كان انتقال الأسرة من “تيسة” إلى فاس، معشوقته الأبدية “ولو كره الكارهون وتقول العنصريون”، لذلك فإن فهم العنوان “وداعا تيسة بالأحضان يا فاس يا بلاد الأسلاف” مفتاح لفهم عمق العلاقة الروحية التي تجمع بين فاس ومحفوظ، فالعنوان يرسم لنا صورة لعناق حار بين الحبيبين: عبد اللطيف محفوظ وفاس بلاد الأسلاف، ويمكننا اعتبار هذا الوصف الأخير “بلاد الأسلاف” علامة من مقوماتها [+هوية] [+انتماء] [+أًصالة] [+جذور] [+وطن] [+تاريخ] والمؤولة التي تتولد عن ضم هذه المقومات هي الثبات والاستقرار والتوازن النفسي، ففاس بالنسبة لمحفوظ أكثر من مجرد مدينة، إنها وطن، و”الذي ما له وطن ما له في الثرى ضريح”، فهي كما قال عنها: “مدينة استقر اسمها في ذهني مثلما تستقر بغداد المسرودة في حكايات الجدات…”.
الإلف والأليف
ينسج محفوظ إذن علاقة محبة وألفة مع الأمكنة التي تؤثث فضاء روايته السيرذاتية، فباستثناء زقاق الزربطانة الذي لا يذكره بخير، فإن جميع الأمكنة المذكورة لا تذكر إلا بألفاظ قدت من معجم الحب: (هواء المحبة، تنفذ إلى روحي، ترحيب وحب خاليين من المجاملة والافتعال، دفء إنساني حقيقي، ابن الدرب، خلان الدرب، الحفاوة والحب، ألفت، رحابة القلوب، حزنت وأنا أودع الحي…..).
كل لفظ من ألفاظ هذا المعجم إذا ما تم الانطلاق منه، أمكن توليد دلالات عدة تلتقي في عقدة عليا لتجعل من المكان مرادفا للألفة وللدفء المنبعث من تلك الألفة.
الدفء الذي كان يشعر به محفوظ في تلك الأمكنة، جعل علاقته بها تتحول إلى علاقة إلف بأليفه، ليتبنى بذلك موقف غاستون باشلار المهاجم للابستمولوجيا الواقعية “ابستمولوجيا الأمكنة الطبيعية” غير المدركة للأهمية الكبرى والمحورية للعلاقة، فالعلاقة التي ننسجها “هي التي تحدد معنى المفاهيم وتوجد امتدادها” وبهذا يكون محفوظ قد أكد ما ذهب إليه غاستون باشلار، من أن المفهوم بدون علاقة “شيك بدون رصيد”.
ألفة الأمكنة التي كان يحسها محفوظ، نجح في نقلها إلى القارئ الذي انخرط بدوره في ذلك الدفء الأصلي، فمثلا في حديثه عن منزل الجارة يامنة الذي كان يدخله دون استئذان لأنه ألف عد منزل الجيران منزله، نفس ذاك الإحساس بالألفة يسري في القارئ الذي يترك منزل الجارة يامنة ليسترجع بدوره الدفء الذي كان يحسه يوما في منزل الجيران، فالمكان إذن ليس شيئا سوى المكان الأليف كما يذهب إلى ذلك غاستون باشلار، بمعنى أن الصورة الفنية التي أبدعها السارد أصبحت ملكا لنا كمتلقين بفعل “تعليق القراءة”، أي أن قراءة المكان في الأدب، تجعلنا نعاود تذكر مكاننا الأليف، بيتنا القديم فـ “ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة” و”لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة”.
تامغريبيت الزمن الجميل
محاولة محفوظ الإمساك بأطياف الأمكنة لم تمنعه من التفكير في الزمن وتغيره وتقلبه وتأثيره على الناس، فكأنه – في مجموعة كثيرة من المقاطع – جاء ليذكرنا بماض ولى وعادات وقيم اندثرت، وسنكتفي هنا بنقل مقطعين:
– “عيد المولد كان على وشك الحلول، وكل عيد في ذلك “الزمكان” يمحو كل خصام، ويغسل القلوب من أدران الأحقاد، فيجعل الجميع ينساه، مهما كان السبب.
كان المتخاصمون يتسابقون منذ الصباح الباكر، للمبادرة بالسلام على خصومهم………. كان المتخاصمان يلتقيان، في الغالب، وسط الطريق بين منزليهما، حيث كل واحد يقصد بيت الآخر، فيتعانقان، ويصر كل واحد على أن يستضيف الآخر، ويستمران في ترديد القسم حتى يصلا عادة إلى الحل الذي تقبله الأعراف، أن يتناولا الفطور في منزل أحدهما، أو في المنزلين بالتناوب، على أن يكون البيت الأول هو بيت من بادر بالقسم أولا… أيام عمها السلام، وحكمها تدين شعبي راقي القيم، ثم ذهب ريحها وريحانها كما يقال…”.
– “استقبلنا الجيران هنا بترحيب وحب خاليين من المجاملة والافتعال. ساعدونا في إدخال الأثاث، وجلبوا لنا قصعة كسكس للغداء، وفي المساء ساعدت الجارات أمي في ترتيب البيت……
أحسست منذ أول يوم، بدفء إنساني حقيقي، وتذوقت معنى أن تكون ابن الدرب…….. في هذا الدرب الذي تحتجب فيه الفوارق الاجتماعية والإثنية الضيقة وتتجاور فيه الجلاليب والتنورات القصيرة والفساتين والبرانس والطرابيش مع البذل العصرية وربطات العنق، أحسست أن رابطة الجوار قوة صهر فريدة، لذلك ربما أحسست أن كل أقراني إخوان. ولم تمض أيام حتى صرت مثلهم، أدخل منازلهم ويدخلون منزلنا دون استئذان أو حرج، فلا نجد عند كل الأمهات إلا الحفاوة والحب”.
إنها نوستالجيا الزمان مثلما هي نوستالجيا المكان.
“أطياف الأمكنة” إذن امتداد للمشروع المحفوظي الذي ابتدأ مع “رهاب متعدد”. إنه سيرة المكان، هذا الأخير الذي لا يتحدد مفهومه – كما مر معنا – إلا من خلال تلك العلاقة التي ننسجها معه والتي هي في نهاية المطاف تحصيل علاقتنا بساكنيه أو بالأحرى بأطيافهم، مادام استرجاع ذكرياتنا معهم يستحيل أن يتحقق إلا كحلم يقظة، ومادام أيضا لا قيمة للمكان في غياب ساكنيه، وذاك ما عبر عنه محمود درويش في انسجام مع عبد اللطيف محفوظ بقوله:
وإن أعادوا لنا الأماكن
فمن يعيد لنا الرفاق؟
—————
هوامش:
1- محفوظ عبد اللطيف، أطياف الأمكنة، دار الفاصلة للنشر، ط 1، 2023، ص 7.
2- نفسه، ص 9.
3- نفسه، ص 10- 9.
4- نفسه، ص 13.
5- نفسه، ص 43.
6- بوخليط سعيد، باشلاريات غاستون باشلار بين ذكاء العلم وجمالية القصيدة، منشورات فكر، ط1، 2009، ص131.
7- غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، 1984، ص37.
8- نفسه، ص 37 – 38.
9- محفوظ عبد اللطيف، أطياف الأمكنة، ص،11-12، بتصرف.
10- نفسه، ص، 81 – 82 بتصرف.
بقلم: نزهة الخو